هل يعلم تأويل القرآن غير الله سبحانه؟ تعدّ هذه المسألة من موارد الخلاف الشديد بين المفسِّرين، ومنشأه الخلاف الواقع بينهم في تفسير قوله تعالى: (وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بـِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا)1، وأنّ الواو للعطف أو للاستيناف؟
قال ابن عاشور التونسي: (المراد بالراسخين في العلم، الذين تمكّنوا في علم الكتاب ومعرفة محامله، وقام عندهم من الأدلّة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى بحيث لا تروج عليهم الشبه. والرسوخ في كلام العرب: الثبات والتمكّن في المكان؛ يقال: رسخت القدم ترسخ رسوخاً إذا ثبتت عند المشي ولم تتزلزل، واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا تضلّله الشبه، ولا تتطرّقه الأخطاء غالباً، وشاعت هذه الاستعارة حتّى صارت كالحقيقة. فالراسخون في العلم، الثابتون فيه العارفون بدقائقه، فهم يحسنون مواقع التأويل ويعلمونه.
ولذا فقوله: (والراسخون) معطوف على اسم الجلالة، وفي هذا العطف تشريف عظيم كقوله: (شَهِدَ اللهُ أنَّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ)2. وإلى هذا مال ابن عبّاس، ومجاهد، والربيع بن سليمان، والقاسم بن محمّد، والشافعيّة، وابن فورك، والشيخ أحمد القرطبي، وابن عطية. وعلى هذا فليس في القرآن آية استأثر الله بعلمها. ويؤيّد هذا أنّ الله أثبت للراسخين في العلم فضيلة ووصفهم بالرسوخ، فآذن بأنّ لهم مزيّة في فهم المتشابه، لأنّ المحكم يستوي في علمه جميع من يفهم الكلام، ففي أيّ شيء رسوخهم؟ وحكى إمام الحرمين عن ابن عبّاس: إنّه قال في هذه الآية: أنا ممّن يعلم تأويله.
وقيل: الوقف على قوله: (إلاّ الله) وأنّ جملة (والراسخون في العلم) مستأنفة، وهذا مرويّ عن جمهور السلف، وهو قول ابن عمر، وعائشة، وابن مسعود، وأُبيّ، ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية، وقاله عمرو بن الزبير، والكسائي، والأخفش، والفرّاء والحنفية.
ويؤيّد الأوّل وصفهم بالرسوخ في العلم، فإنّه دليل بيّن على أنّ الحكم الذي أثبت لهذا الفريق هو حكم من معنى العلم والفهم في المعضلات وهو تأويل المتشابه. على أنّ أصل العطف هو عطف المفردات دون عطف الجمل، فيكون الراسخون معطوفاً على اسم الجلالة فيدخلون في أنّهم يعلمون تأويله. ولو كان الراسخون مبتدأ، وجملة يقولون آمنّا به خبراً، لكان حاصل هذا الخبر ممّا يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زيغ في قلوبهم، فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة. قال ابن عطية: تسميتهم راسخين تقتضي أنّهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب، وفي أيّ شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلاّ ما يعلمه الجميع، وما الرسوخ إلاّ المعرفة بتصاريف الكلام بقريحة معدّة.
وما ذكرناه وذكره ابن عطيّة لا يعدو أن يكون ترجيحاً لأحد التفسيرين، وليس إبطالاً لمقابله إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرّق بين ما يستقيم تأويله، وما لا مطمع في تأويله)3.
وقال الرازي: (وما يعلم تأويله إلاّ الله اختلف الناس في هذا الموضع، فمنهم من قال تمّ الكلام ههنا، ثمّ الواو في قوله والراسخون فـي العلم واو الابتداء، وعلى هذا القول لا يعلم المتشابه إلاّ الله، وهذا قول ابن عبّاس وعائشة ومالك بن أنس والكسائي والفرّاء، ومن المعتزلة قول أبي علي الجبائي، وهو المختار عندنا.
والقول الثاني: إنّ الكلام إنّما يتمّ عند قوله والراسخون في العلم وعلى هذا القول يكون العلم بالمتشابه حاصلاً عند الله تعالى وعند الراسخين في العلم، وهذا القول أيضاً مرويّ عن ابن عبّاس ومجاهد والربيع بن أنس وأكثر المتكلِّمين)4.
موقف الطباطبائي في المقام
(ذهب بعض القدماء والشافعية ومعظم المفسِّرين من الشيعة إلى أنّ الواو للعطف وأنّ الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه من القرآن، وذهب معظم القدماء والحنفية من أهل السنّة إلى أنّه للاستئناف وأنّه لا يعلم تأويل المتشابه إلاّ الله، وهو ما استأثر الله سبحانه بعلمه. وقد استدلّت الطائفة الأُولى على مذهبها بوجوه كثيرة وببعض الروايات، والطائفة الثانية بوجوه أُخر وعدّة من الروايات الواردة في أنّ تأويل المتشابهات ممّا استأثر الله سبحانه بعلمه، وتمادت كلّ طائفة في مناقضة صاحبتها والمعارضة مع حججها.
ما ينبغي للباحث أن يتنبّه له في المقام أنّ المسألة لم تخل عن الخلط والاشتباه من أوّل ما دارت بينهم ووقعت مورداً للبحث، فاختلط المعنى المراد من المتشابه بتأويل الآية كما ينبئ به ما عنونّا به المسألة وقرّرنا عليه الخلاف وقول كلّ من الطرفين، لذلك أغضينا عن نقل حجج الطرفين؛ لعدم الجدوى في إثباتها أو نفيها بعد ابتنائها على الخلط.
والذي ينبغي أن يُقال: إنّ القرآن يدلّ على جواز العلم بتأويله لغيره تعالى، وأمّا هذه الآية فلا دلالة لها على ذلك.
أمّا الجهة الثانية: فإنّ الآية بقرينة صدرها وذيلها وما تتلوها من الآيات إنّما هي في مقام بيان انقسام الكتاب إلى المحكم والمتشابه، وتفرّق الناس في الأخذ بها، فهم بين مائل إلى اتّباع المتشابه لزيغ في قلبه، وثابت على اتّباع المحكم والإيمان بالمتشابه لرسوخ في علمه. فإنّما القصد الأوّل في ذكر الراسخين في العلم بيان حالهم وطريقتهم في الأخذ بالقرآن ومدحهم فيه قبال ما ذكر من حال الزائغين وطريقتهم وذمّهم، والزائد على هذا القدر خارج عن القصد الأوّل، ولا دليل على تشريكهم في العلم بالتأويل مع ذلك إلاّ وجوه غير تامّة، فيبقى الحصر المدلول عليه بقوله: وما يعلم تأويله إلاّ الله من غير ناقض ينقضه من عطف واستثناء وغير ذلك. فالذي تدلّ عليه الآية هو انحصار العلم بالتأويل فيه تعالى واختصاصه به. لكنّه لا ينافي دلالة دليل منفصل يدلّ على علم غيره تعالى به بإذنه كما في نظائره مثل العلم بالغيب، قال تعالى: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالأرْضِ الْغَيْبَ إلاّ اللهُ)5 ، وقال تعالى: (إنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ)6 ، وقال تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إلاّ هُوَ)7، فدلّ جميع ذلك على الحصر. ثمّ قال تعالى: (عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبـِهِ أحَداً * إلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُول)8 ، فأثبت ذلك لبعض من هو غيره وهو من ارتضى من رسول، ولذلك نظائر في القرآن.
أمّا الجهة الأولى وهي جواز العلم بتأويله لغيره تعالى، فإنّه تعالى قال: (إنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتاب مَكْنُون * لا يَمَسُّهُ إلاّ الْمُطَهَّرُونَ)9 ولا شبهة في ظهور الآيات في أنّ المطهّرين من عباد الله يمسّون القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون والمحفوظ من التغيّر، ومن التغيّر تصرّف الأذهان بالورود عليه والصدور منه، وليس هذا المسّ إلاّ نيل الفهم والعلم، ومن المعلوم أيضاً أنّ الكتاب المكنون هذا هو أُمّ الكتاب المدلول عليه بقوله تعالى: (يَمْحُو اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبـِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ)10 وهو المذكور في قوله: (وَإنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ)11.
وهؤلاء قومٌ نزلت الطهارة في قلوبهم، وليس ينزلها إلاّ سبحانه، فإنّه تعالى لم يذكرها إلاّ كذلك أي منسوبة إلى نفسه كقوله تعالى: (إنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)12، وقوله تعالى: (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)13، وما في القرآن شيء من الطهارة المعنوية إلاّ منسوبة إلى الله أو بإذنه، وليست الطهارة إلاّ زوال الرجس من القلب، وليس القلب من الإنسان إلاّ ما يدرك به ويريد به، فطهارة القلب طهارة نفس الإنسان في اعتقادها وإرادتها وزوال الرجس عن هاتين الجهتين، ويرجع إلى إثبات القلب فيما اعتقده من المعارف الحقّة من غير ميلان إلى الشكّ ونوسان بين الحقّ والباطل، وثباته على لوازم ما علمه من الحقّ من غير تمايل إلى أتباع الهوى ونقض ميثاق العلم، وهذا هو الرسوخ في العلم، فإنّ الله سبحانه ما وصف الراسخين في العلم إلاّ بأنّهم مهديّون ثابتون على ما علموا غير زائغة قلوبهم إلى ابتغاء الفتنة، فقد ظهر أنّ هؤلاء المطهّرين راسخون في العلم.
هذا، لكن ينبغي أن لا تشتبه النتيجة التي ينتجها هذا البيان، فإنّ المقدار الثابت بذلك أنّ المطهّرين يعلمون التأويل، ولازم تطهيرهم أن يكونوا راسخين في علومهم، لما أنّ تطهير قلوبهم منسوب إلى الله وهو تعالى سبب غير مغلوب، لا أنّ الراسخين في العلم يعلمون التأويل بما أنّهم راسخون في العلم، أي أنّ الرسوخ في العلم سبب للعلم بالتأويل فإنّ الآية لا تثبت ذلك، بل ربّما لاح من سياقها جهلهم بالتأويل حيث قال تعالى: (يَقُولُونَ آمَنّا بـِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) وقد وصف الله رجالاً من أهل الكتاب برسوخ العلم ومدحهم بذلك وشكرهم على الايمان والعمل الصالح في قوله: (لكِنِ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بـِما أُنْزِلَ إلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ)14. ولم يثبت مع ذلك كونهم عالمين بتأويل الكتاب)15.
والحاصل أنّ الآية ليست بصدد إثبات أنّ الرسوخ في العلم سببٌ للعلم بالتأويل كما تصوّره القائلون بأنّ الواو للعطف، لذا لا يثبت أنّ كلّ راسخ في العلم عالم بالتأويل بالضرورة، وإنّما الثابت أنّ العلم بالتأويل سبب للرسوخ في العلم.
ـــــــــــــــــــــ
(1) آل عمران: 7.
(2) آل عمران: 18.
(3) التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، تأليف: سماحة الأُستاذ الإمام الشيخ محمّد الطاهر ابن عاشور، طبعة جديدة منقّحة ومصحّحة، مؤسّسة التاريخ، بيروت، الطبعة الأولى، 1420هـ: ج3 ص24.
(4) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: ج7 ص152.
(5) النمل: 65.
(6) يونس: 20.
(7) الأنعام: 59.
(8) الجنّ: 26 - 27.
(9) الواقعة: 77ـ 79.
(10) الرعد: 39.
(11) الزخرف: 4.
(12) الأحزاب: 33.
(13) المائدة: 6.
(14) النساء: 162.
(15) الميزان في تفسير القرآن: ج3 ص49.
المصدر: تأويل القرآن بين النظرية والمعطيات


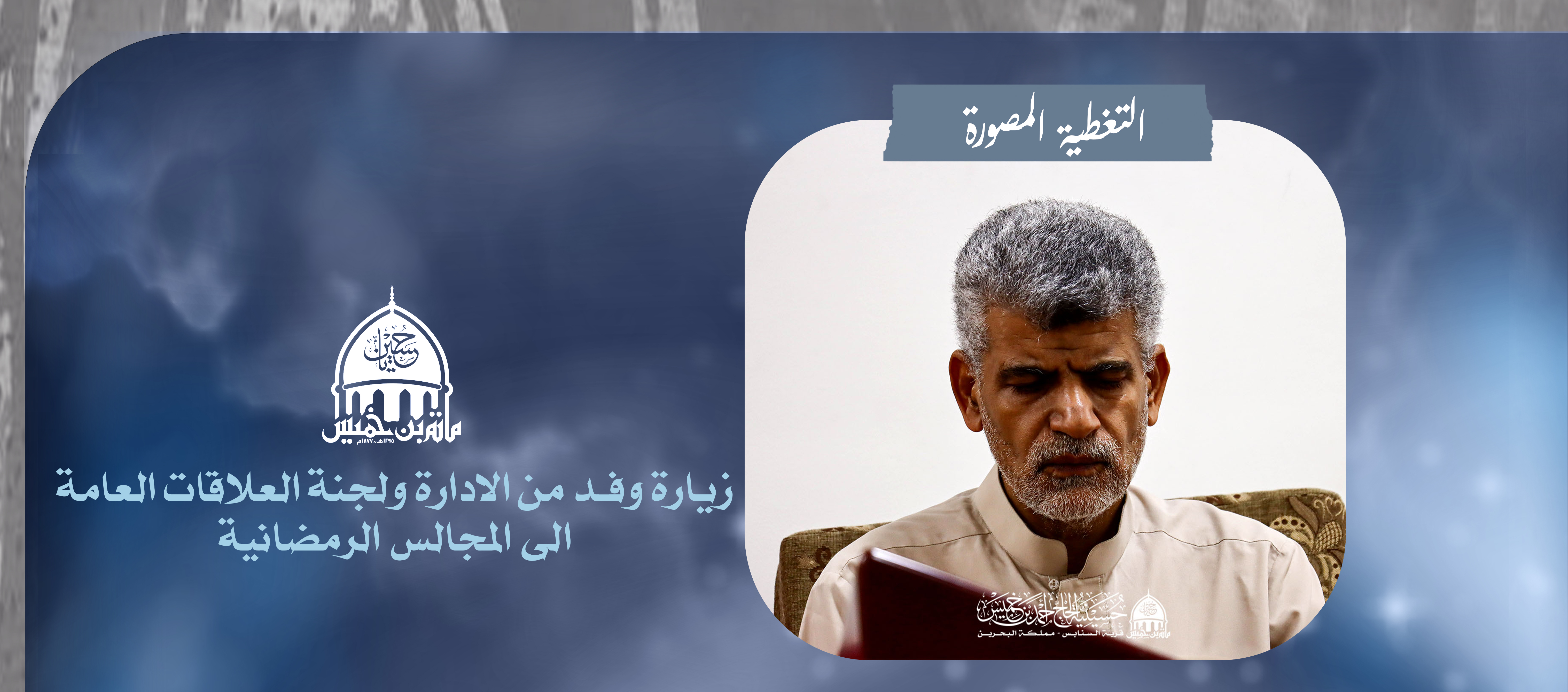

التعليقات (0)