سأبكي بحرارة 
يا بيتي الجميل البارد
سأرنو إلى السقف والبحيرة والسرير
وأتلمس الخزانة والمرآة
والثياب البارده
سأرتجفُ وحيداً عند الغروب
والموتُ يحملني في عيونه الصافيه
ويقذفني كاللفافة فوق البحر ....
............
اشعر بثمة مدينة من الحزن تغتال قلب ذلك الشاعر الذي رحل مخلفاً وراءه سبعين عاماً من الحزن والموت والسياط والزنازين ، أشعر بثمة وجعاً لا يفتأ وأنا أرى تلك السيجارة لا تفارق شفتيه الذابلتين ، أوعندما أنظر إلى عينيه المغرورقتين ، أبصر زرقة السماء فيهما ، وأدمعاً تود لو تهرب من المآقي إلى خارج سجنها المتوهج .
الشاعر الذي فرت كلمات " أدونيس " من تحت قلمه ، الشاعر الذي كنت أقول عنه أنه قسيس الكلمة والحرف ، وربان الشعر وسفينة الحزن ، كنت أقرء في شعره المتناثر على الأوراق كالبلور ، ألقاً من نوع آخر ، وسفر من الكلمات التي تطير إلى عالم الحرية وسمائها الزرقاء ، كنت أقرء في شعره حمامات بيضاء ، لكنها جريحة ، تتقاطر منها الدماء كجرح غزير .
ذلك الرجل الذي يتكأ على عصاه أحياناً وتارة على كرسيه المتحرك ، ذلك الرجل السبعيني الذي خطفه الموت ، لكن لم يستطع الموت وذاكرة النسيان أن تنسيه من ذاكرتي الغجرية ، ذلك الرجل الذي خطفته السجون ولكن لم تستطع سياط السجان ولا فيلقته أن تنسي العالم كلماته ودموعه .
أنه الشاعر " محمد الماغوط " ، الشاعر السوري الذي حمل أنفاساً عاتية كالريح ، الراحل الذي ما فتأ يطارد الكلمات والسجان ، وقساوة السجن الذي طحنه سنين طويلة ، " محمد" الرجل القروي البسيط ، الذي يرعى الأغنام ويعمل في الحقول ، لم يكن يتوقع في يوم من الأيام أن يحصل على جائزة من مهرجان دبي للأدب ، الجائزة التي أتت في وقت متأخر جداً ، اللا أنه كان فخوراً بها ، الجائزة التي كانت مصدر اعتزازا وفخر له كثيرا .
" الماغوط " الرجل البسيط ، الانسان الذي يتوارى دائما عن أضواء الكاميرات وصخب اللقاءات التي تظهره على وسائل الاعلام ، كان بينه وبين الغرور مساحات شاسعة جداً ، انسان متواضع إلى ابعد الحدود ، اللا أن السنين لم تبقي ولم تذر عليه بتاتاً ، فالفقر الذي عصف بعائلته الصغيرة والسجن الذي ما أبقى له شيئ ، وفقد زوجته الشاعره كان أكبر هماً طارده طيلة حياته .
عندما أقرء سيرته الذاتية أو أقرء شيئاً من شعره ، اشعر وكأنه يأخذني إلى عالم آخر ، عالم مملوء بالحزن ، عالم لا يطأه اللا الذين يتدثرون بعباءات من الألم والدموع ، وتارة ينطلق بك إلى شواطئ أخرى ، شواطئ تمتلأ بالحب والعذوبة ، لكنها غالباً ما تكون قريبة من ساحل الحزن الأسود ، وتارة يطير بك إلى السجن وركلات السجان وتارة يحلق بك في سماء الحرية الجميلة ، وفي معظم الأحيان يجعلك تجلس معه على أرصفة الشام لتستمع إلى فيوضاته وأوتاره الشعرية الفريدة .
الرجل الذي عشق الشام وأحب أزقتها وحيطانها وأشجارها ، الرجل الذي كان تتنفس رئتاه نسيم بلاده ، رغم أنها التي تسببت في ضياع سنوات من عمره حزيناً وتائهاً تصفع به السبل وتتلاقفه السجون ، من سجن إلى سجن بلا جرم أو قصيدة .
كان يقول دائماً أنه تعلم من السجن الكثير ، الكثير الكثير ، لأن السجن غّير مجرى حياته ، علمه القراءة والكتابة وتمنى لو لم يكن كذلك ، كان يتمنى أن لو بقي جاهلا وغجرياً يرعى الأغنام في الضيعة ، ويسقي الزرع ويحرث الحقول الخضراء .
أتحير أمام شخصك ، ماذا أكتب وكيف أكتب ؟ وهل أخذت أكثر مما أعطيت ! ؟ أقف متحيراً ومذهولاً ، يتحير القلم بين أصابعي عندما أحاول الكتابة عن أي جانب من حياتك الحزينة وحتى المفرحة ... لأنني أجد صدقاً من نوع آخر يترنح ويأخذ طابعاً جميلاً على حياتك التي لفها الحزن من الشرق إلى الغرب وجعلك تقول :
" دموعي زرقاء من كثرة ما نظرت إلى السماء وبكيت ، دموعي صفراء من طول ما حلمت بالسنابل الذهبية وبكيت فليذهب القادة إلى الحروب والعشاق إلى الغابات والعلماء إلى المختبرات أما أنا فسأبحث عن مسبحة وكرسي عتيق لأعود كما كنت حاجباً قديماً على باب الحزن ما دامت كل الكتب والدساتير والأديان تؤكد أنني لن أموت اللا جائعاً أو سجيناً " .


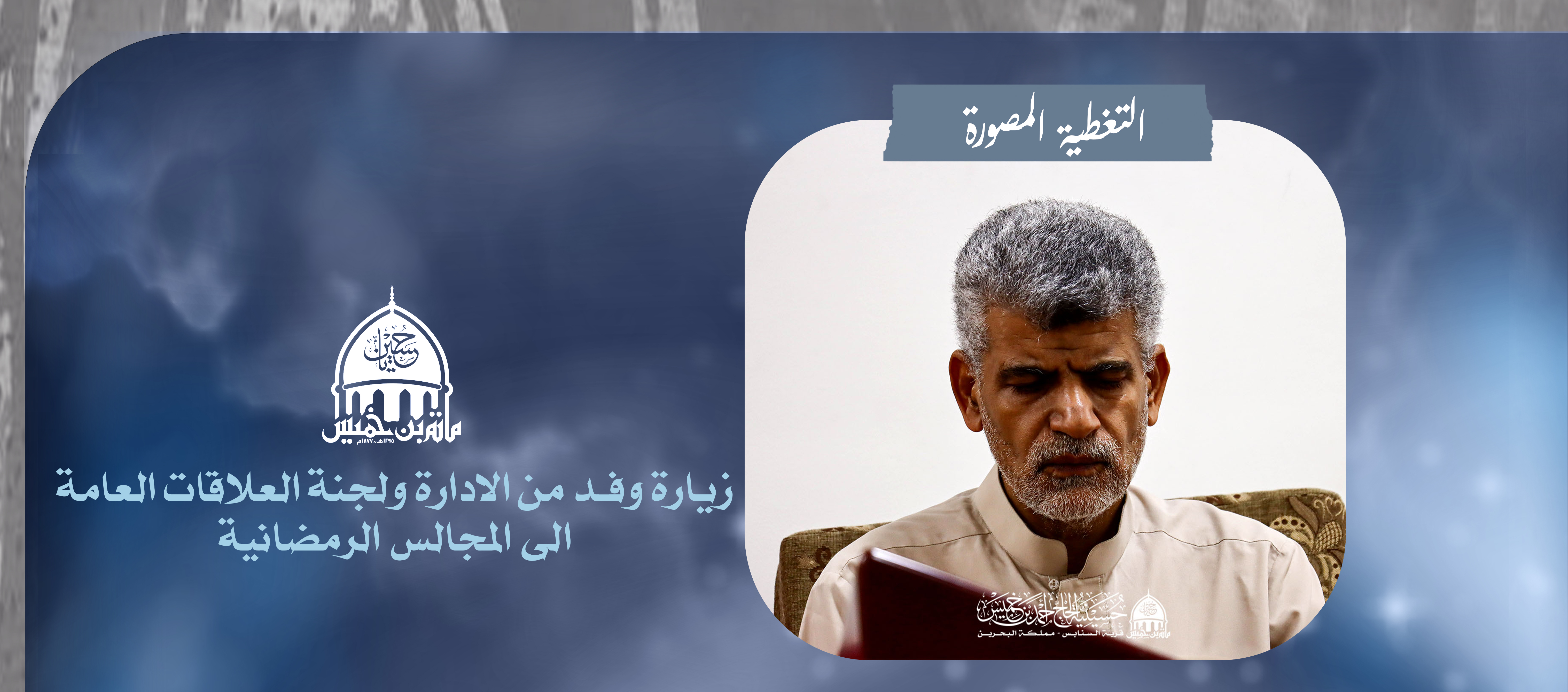

التعليقات (0)