قراءة في نموذج الدولة " إنتهى زمن الثورات الشعبية " بريجنسكي
في الحادي عشر من شهر فبراير شباط من عام 1979 م أجهز الإسلاميون الثوريون بقيادة الإمام الخميني (قد) رسمياً على حكم الأسرة البهلوية في إيران، مُنهين بذلك عقوداً من الزمن عاشت فيه تلك البلاد تحت وصاية حكم متطرف في عسكريته وقمعيته وتبذيره للثروة الوطنية إلى أبعد الحدود .
لقد بدأت قصة الصراع السياسي بين الإمام الخميني الراحل والأسرة البهلوية منذ أن التقت الفلسفتان المتباينتان لكل منهما على حدود سياسية تماسية حمراء، فقد شاء الحكم البهلوي أن يؤمرك سياسة البلاد بصورة دراماتيكية لم تتحملها أنسجة الدولة بامتداداها المُتجذرة في روح الإنسان الفارسي المُتشبّع بتاريخ إمبراطوري وحضاري عريق، ومن ثم اندفعت بلا تحكم في التماهي حتى النخاع بالنموذج الغربي سوسيولوجياً متخطية بذلك مرة أخرى بنيوية المجتمع الإيراني بكل ما يحويه من تمثلات دينية وعُرفية وسلوكية .
ومن الأهمية بمكان لمن يرمي إلى معرفة أهمية الحركة السياسية الخمينية ومدى التأثير الذي أحدثته على ميزان القوى في العالم وكذا على مفاهيم دينية في الفكر الإسلامي أن يقرأ بصورة عمودية أوضاع الحركة الإسلامية ( سنية وشيعية ) في العالم الإسلامي قبل انتصار الثورة في إيران، حين كانت تلك الحركات الإسلامية بشتى أطيافها الفكرية (إلاّ ما ندر) لا تحمل مشروع دولة متكامل يفي بمتطلبات الواقع الدولي ولا يتجاوز حرمة الأيدلوجية الدينية في نظرتها للحكم، حيث كانت مجاميعٌ كثيرة من تلك الحركة قد ركنت وانزوت إلى الظل بعد دخولها في مواجهات خاسرة سلفاً (بسوء تقدير أحياناً) مع الأنظمة اللائكية في الوطن العربي والإسلامي، تمظهر ذلك بالخصوص في جماعة الإخوان المسلمين في مصر التي حدت سياسة البناء التربوي للفرد المسلم مؤجلة بذلك كل أجندتها السياسية، كما أن بعضاً من تلك الحركات – وبالأخص في باكستان - دخلت ( أو أُدخِلت عن طريق أجهزة المخابرات دون أن تُدرك ) في مشاريع الحرب الباردة بجانب الولايات المتحدة لمواجهة المد الأحمر القادم من الشمال والشمال الشرقي للقارتين الآسيوية والأوربية، كما بقي النفس الكلاسيكي التقليدي هو المُهيمن على مفاصل الجسم الديني في النجف الأشرف وقم المقدسة وأطراف من أرض الهلال الخصيب والخليج بمنسوبات مختلفة، صاحَبَ ذلك الجو مناخ من اليأس الحضاري للشعوب الإسلامية والرغبة (بالمأمول) في أن تتغير الأوضاع الإسلامية نحو الأفضل، وكان هناك همس من هنا وهناك يُتداول في الأوساط الدينية من أن العالم الإسلامي ينتظر فوراناً للقيم ونفض لغبار الخنوع الضارب بأضنابه على مفاصل جسمه المترهل، ولكن السؤال كان أيضاً: أين سيقع ذلك ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ .
ومع بدايات النصف الثاني من القرن العشرين بدأ جناح إسلامي ثوري في النمو بصورة اضطرادية منطلقاً من مدينة قم المقدسة ينادي بقيام دولة إسلامية على مبدأ حكم الفقيه بقيادة أية الله العظمى السيد روح الله الخميني ( وإن لم يكن يُصَرَّح بذلك علناً )، وكان ذلك الجناح يمثل تمرداً حقيقياً ليس فقط ضد نظام الشاه بل ضد أزمنة طويلة من الحديث بقبول إصلاحات دستورية بانتظار وعد الله في إظهار الإمام المهدي (ع) ، وقد بدأ الإمام الخميني كفاحه وخطابه السياسي مستنداً على عدة محاور :
· توظيف الأوضاع السياسية والاجتماعية المتردية التي كانت تعيشها إيران في ظل حكم الأسرة الشاهنشاهية لصالح شعارات الإصلاح السياسي التي كان يُنادي بها .
· إقناع الجماهير بضرورة التغيير الجذري وعدم القبول بأنصاف الحلول للأزمة السياسية وتطبيق تجربة حكم الإسلام ، وبما أن الخطاب الإسلامي كان يمتاز باليُسر والوضوح؛ ويقدم إجابات سهلة لمشكلات المجتمع إذ يختزل سبب المشكلات بالبعد عن شرع الله ومن ثم فالحل هو التطبيق الصحيح للشريعة الإسلامية الموعودة والتي ستكون مبنية على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الناس وإشاعة الأمن والرخاء وبالتالي فإن فرصة الإستقطاب للجماهير كانت موفورة الحظ .
· توظيف الثقافة الشيعية الغنية بالرموز والدلالات في إلهاب مشاعر الجماهير وتجيشها ضد استبداد السلطة .
كما أن الإمام الخميني استغل تعثر الآيدولوجيات والأفكار القومية والليبرالية والأزمة التي كانت تواجهها على مستوى الفكر والتنظيم والممارسة في إيران وعدم وجود أرض خصبة لنمو تلك الأفكار نظراً لاعتبارات تتصل بالتكوين الثقافي و العقيدي عند الإيرانيين حيث يسود طابع التدين والتمسك بالتقاليد، كما أن مسلسل التراجعات والإنكسارات للفكر القومي والليبرالي قد أفقد الثقة الشعبية في صدقيته، كما أن خطاب الإمام كان يعكس دلالات اجتماعية وسياسية مهمّة، فهو أولاً ينتمي إلى الطبقة الفقيرة اجتماعياً، ومن ثم فهو يطرح مقولة العدل التوزيعي في مواجهة التفاوت الإجتماعي التي كانت تشهده إيران، كما أنه كان يؤكد باستمرار على ضرورة صيانة الاستقلال الوطني ورفض التبعية للغرب وهو ماجعل قدرته على استقطاب الفئات والشرائح الاجتماعية التي كانت تعاني من جراء السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعثرة التي تنتهجها الحكومة الشاهنشاهية ( ومن المفارقات أن رجل الريف المُعدَم كان هو صاحب القرار بعد انتصار الثورة الإسلامية ) .
استغل الإمام كل ذلك وطرح مشروعه السياسي الإسلامي .
وبعد أن قُيّض للإمام الخميني أن ينجح في حركته السياسية ويُسقط النظام الحاكم بدأ في صياغة الدولة الجديدة وفق أطر الآيدلوجية التي نادى بها سلفاً وهي الحكم الإسلامي المبني على مبدأ ولاية الفقيه (المشروعية والكفاءة)، كان الإمام يرى بأن مدخل الإسلام لنظرية الحكم يكمن من باب ولاية الفقيه التي يرجع تاريخ نشوئها إلى ألف سنة خلت؛ حين طرحها سبط الشيخ الطوسي وليس كما يخطأ البعض من نسْبِها إلى الشيخ النراقي في القرن الثاني عشر الهجري.
إلا أن الإمام كذلك لم يشأ أن يتجاوز التجربة الإنسانية في نظريات الحكم وفي كيفية صياغة مفهوم الدولة الحديثة من فصل للسلطات والاحتكام لصناديق الإقتراع، رغم ما كان ينادي به بعض فقهاء إيران من ضرورة قيام دولة العدل الإلهي التي لا يحكمها الإنتخاب ولا تخضع للمساءلة، وبدأت المزاوجة بإحكام بين إسلامية النظام وجمهرته وبناء نظام شديد التعقيد، ولأهمية ذلك الطرح الخميني وما أفرزة من نظام سياسي جديد يمكن الوقوف على بعض ملامِحه العمليه وانعكاساته الفكرية والدينية والسياسية :
1. انطلقت الدولة في إيران من خلال رؤية تحليلة للنظام وأدواته ووسائله ولمراكز القوى المؤثرة في المجتمع، ومن خلال فهم علمي للواقع رافضة الأفكار الهلامية المجردة التي تفصل بوعي وبدون وعي بين التصورات الذهنية والعمل السياسي الثوري، ولهاذا كانت تمزج بين الفكر والممارسة من خلال منظومة جدلية واعية .
2. تداعي مقولة الترابط بين العلمانية والديمقراطية على نحو ما هو شائع في الكثير من الأدبيات الغربية والعربية التي تعتبر العلمنة شرطاً لازماً لعملية الانتقال الديمقراطي على اعتبار أن علمنة الفضاء السياسي هي التي تسمح بتأسيس قيمة المواطنة السياسية وترسيخ مبدأ التسامح الديني والتعدد السياسي، وبذلك جاءت الدولة في إيران مفندةً للأوهام الشائعة في سوق العلمانيات المسطحة التي تعتبر الإسلام عائقاً للحركة الإسلامية .
3. برهنت الدولة في إيران على القدرة في الإلتقاء على مستوى مظلة الشرعية الإسلامية كما يمثلها الدستور الإيراني وتراث الثورة بين مختلف الأطراف المتنافسة مع الاختلاف في مستوى الخلفية الفكرية والقراءات التأويلية التي تستند لهذه الشرعية .
4. راعت الدولة في إيران التطبيق الإلهي وفق العقيدة الدينية مع عدم إهمال عنصر المرونة في الأحكام الشرعية والتكيف مع تعرجات السياسة الزمانية والمكانية، بالإضافة إلى أنها رسخت بين القناعات العقائدية والتفريعات التفصيلية في الإسلام باعتباره الدين الخالد .
5. الاهتمام بالمرتكزات الإنسانية من إيمان وعدل وأخلاق سياسية وقومنة النظام على خطوطها، وبالتالي تأصيل ذلك الأساس وتلك المرتكزات على شكل إطار إنساني عام يستهدف تحقيق المجتمع المدني المسلم عن طريق إشاعة مظاهر السلوك المتدين المعتدل في الحياة العامة .
6. رسّخت مفهوم الديمقراطية بكل استحقاقاتها من فصل للسلطات والاحتكام لصناديق الإقتراع بشكل لا لبس فيه، فالشعب له حضوره الفعلي بشكل دائم في صنع القرار لجميع حيثيات النظام السياسي الإجرائية والتشريعية :
· مجلس الخبراء
· الولي الفقيه
· رئاسة الجمهورية
· والبرلمان
· المجالس البلدية
· ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور
حيث جرت منذ انتصار الثورة وإلى الآن أكثر من 24 عملية انتخاب لعدة جهات في الدولة، وإعطاء دور أوسع للمؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة والعمل على ترسيخ الإنتقال الديمقراطي ضمن غطاء الشرعية الدستورية، رغم آيديولوجيا الدولة القائمة على الخلفية الدينية التي تعطي دوراً مركزياً للإمامة الدينية والسياسية .
7. تأصيل مفهوم السلطة الجمعية وإلغاء السلطة الأحادية الاحتكارية، فالصلاحيات التنفيذية موزعة على مختلف القوى في الدولة بشكل متوازن وفق الدستور لكي لا تكون هناك استبدادات جِهوية في صنع القرار .
8. طبقت نظرية المراقبة البينية على كافة القوى العاملة؛ فالمرشد مراقب من قِبَل مجلس خبراء القيادة ( 86 عضو ) في كيفية إدارته للسياسات الكلية كما أنه مراقب من قِبَل السلطة القضائية في أمواله وأموال عائلته وأصحابه، والبرلمان يحاسب الحكومة، والبرلمان نفسه مراقب من قبل مجلس صيانة الدستور وهذا الأخير عليه نفوذ من مجمع تشخيص مصلحة النظام، ومجمع التشخيص مراقب من قبل المرشد .
9. تعطي الدولة السياسة الخارجية بُعداً إنسانياً واضحاً، فهي لا تحرك سياساتها وعلاقاتها بتقدير المصالح فحسب وإنما تُدار بقيم أخلاقية مع عدم تحكّم تلك القيم بصورة سلبية على حساب مصالح الدولة المباشرة وهي السياسة التي كانت تتبعها الأنظمة الإشتراكية في الماضي حين أنفقت الكثير على مشاريع آيدولوجية خاسرة حتى أفلست.
10. مارست الدولة سلوكاً مهمّا في العمل السياسي يتعلق بتزكية السياسين عند توليهم مناصب سياسية في الدولة فلا يمكن أن يكون رئيس الدولة رجل غير سوي، أو أنه يملك تاريخاً سياسياً وسلوكياً مشبوهاً، بل يجب أن تتوفر فيه الصفات الإنسانية بل حتى مفردات التدين ليكون بذلك صاحب وازع شخصي تجاه أي إنحراف إداري أو مالي يحصل في الدولة، كما أن رساميل المال والتجارة لا تُسقِط أو تُنجِح المسؤولين السياسين وفق مصالحاها التجارية كما يحصل في بعض البلدان .
11. كرّست حقوق المواطنة لكافة أفراد الشعب من حقوق عامة وتفصيلية بدءاًً بحرية الصحافة (1150 صحيفة تصدر في إيران) وحرية تشكيل النقابات والاتحادات الطلابية والمهنية والنسائية والتكتلات السياسية (110 أحزاب شاركت في الانتحابات البرلمانية الأخيرة) .
12. المحافظة على حقوق الأقليات الموجودة من خلال عقد المواطنة، فقد ضمنت لهم الدولة حق المشاركة البرلمانية والسياسية ، وقد بيّن ذلك الدستور الإيراني بجلاء بالنسبة للأقليات الموجود في إيران، حيث ينتخب الزرادشت واليهود كل على حدة نائباً واحداً وينتخب المسيحيون الآشوريون والكلدانيون معاً نائباً واحداً وينتخب المسيحيون الأرمن في الجنوب والشمال كل على حدة نائباً واحداً، علماً بأن القانون يسمح بزيادة واحد عن أي أقلية تزيد عن عددها الأصلي 100 ألف نسمة .
في نهاية الحديث وعلى إثر كل ذلك ألا يصح أن تكون التجرية الإيرانية مخزونا هاماً من الإبداع الفكري والسياسي يُضاف للتجربة الإنسانية، ومن ثم يكون مادة حيوية يمكن لبعض الدول العربية والإسلامية التي امتهنت تحقير الإنسان وسلب كرامته الاستفادة منها، ثم أَلَمْ يحن الوقت بعد لكي تخرج الدول العربية والإسلامية (ساسةً ومثقفين) من تأثير الإعلام الأمريكي المُتصَيهِن والمُوَجَّه الذي يُصَوِّر الثورة في إيران بالبعبع الطامع بأراضي الغير .
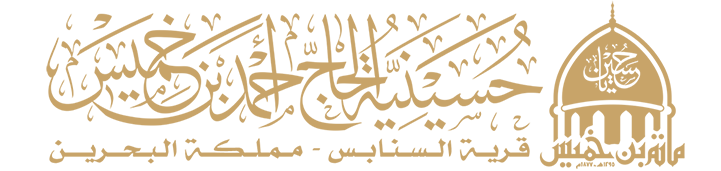



التعليقات (0)