لِمَنْ لا يُجِيْدُ الفَرْق بَيْنَ الخَبَرِ والاخْتِبَار
لقد أسرف رئيس حركة نهضة آزادي إيران المعارضة إبراهيم يزدي في مُرافعته المدافعة عن الولايات المتحدة ضد بلاده بصورة مُقزّزة. يزدي قال كلاماً لا يُغفر لقائله في السلم فكيف به إذا قِيل في أتون اصطكاك الأسِنّة.
فهو يعيش في بلد يُمسي ويُصبح على تهديدات بضربة عسكرية تستهدف منشآته النووية والدفاعية. قد يتلقاها (عبر) إحدى جواره المباشر أو غير المباشر ممن يجيدون الرقص بين هويتهم وهوية الأجنبي.
بالتأكيد ليس الشعار الإيراني اليوم هو «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» لكنه أيضاً ليس أقل من مخالفة تمرير الصوت للآخرين وكأنه «رسالة مخملية» يتم إرسالها في ظروف تسمح بأن تُسمع جيداً ويُبنى عليها حرف.
هو يتذكّر أنه قال لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في الحادي والعشرين من شهر مارس/آذار من العام 2007 إن حركته تجاوزت الخطوط الحمراء في انتقادها للإمام الخميني. وهو يعلم أنه اليوم (وإن قال إنه يَرِثُ حزباً إسلامياً) يَتَلَبْرَل بما فيه الكفاية لكي يبقى معارضاً متجدداً ومُتخففاً في الوقت نفسه.
وعلى رغم كل ذلك فإن حركته تمارس نشاطها في إيران. بل إن منتسبيها وأعضاءها يُشاركون في الترشّح وليس الترشيح خلال الانتخابات العامة. ويزدي يعرف ذلك جيداً ما دام يُدرك الفرق بين الخبر والاختبار.
فبعد انتخابات العام 2005 الرئاسية تحالف يزدي مع تسعة أحزاب إصلاحية وفي طليعتها جبهة المشاركة ومجاهدو الثورة الإسلامية المتطرفتان ومعهم تنظيمات قومية وخمسة وثلاثون ناشطاً، ووقّعوا اتفاقاً لمواجهة المحافظين. إذاً هو يسوس كغيره في اللعبة. لكنه كثير التباكي على حاله وأحوال بلده.
يزدي رجل نال تعليمه في الغرب. وأولاده وأحفاده كلهم من دون استثناء يعيشون في الولايات المتحدة الأميركية. لذا فإنه بالتأكيد سيقبل بالتحكيم الغربي في قضايا بلده. وقد يُوليها ثقة أكبر نتيجة هوسه من «أوتوقراطية» بلاده الدينية.
مؤسسة سوشيال تكنولوجيز الأميركية قالت كلاماً مُحدداً قبل أقلّ من شهر يتعلّق بمؤشر سرعة التغيير لدى الدول. فـ «التحول الحضري ونسبة التعليم وإجمالي الناتج المحلي للفرد والحريات المدنية والوصول إلى الهاتف والتلفزيون والإنترنت في البلدان المعنية في الخمسة عشر عاماً الماضية» كلها معايير كلما تغيّرت سجّلَ البلد درجة أعلى.
الجمهورية الإسلامية (وبحسب الدراسة) حصلت على اللون الأخضر بحسب التقسيم المنهجي للدراسة. وهي تتساوى في ذلك مع كل من روسيا وإسبانيا وفنلندا من ناحية التغيّر. فإن قَبِلَ يزدي بهذا التحكيم فعليه أن يُفسّر كثيراً من مواقفه السياسية. وإن لم يقبل فلربما تحاشياً منه لأن لا يُواجه ما يُعيق أزليّة نِدّيّته للنظام الإيراني.
ويتشارك إبراهيم يزدي مع غيرشوم غورينبرغ في كل شيء إلاّ في توصيفه الديمقراطية بأنها «منوطة بمدى الحرية في المجتمع وليس بهيكليتها»؛ لأنه إن قَبِل فعليه أن يشرح ما قاله للزميلة منال لطفي عندما قابلته في طهران العام الماضي «لدينا حرية. بمعني إنكِ يمكن أن تأتي وتتحدثي معي، وأنا لا أخاف بأن أخبرك بماذا أعتقد». هكذا قال، وهكذا يجري التناقض.
في أحد جوانب الترف اليزدي قال الرجل كلاماً غير مفهوم. فهو لا يُجانس أبداً بين خيارات الحكم وخيارات الناس في مراحل التنفيذ بسبب تشتّت التوجهات والمسارات، ليُحيلها لاحقاً (وبشكل مرتبك) إلى حالة انفصال تام بين قاع الهرم وقمّته.
وهو يُدرك أن التماهي النفسي، والبرمجة السياسية تتقارب إلى حد التخوم لحظة تقديم العطاءات الانتخابية، لكنها تفترق عندما يبدأ الطرفان بالعمل على كسب القبول الثنائي والمتبادل بانصراف السياسيين إلى الحكومة والناخبين إلى مجتمعاتهم وحوانيتهم.
87 في المئة من يهود الولايات المتحدة الأميركية يُؤيدون التفاوض بين الفلسطينيين والصهاينة للوصول إلى حل يقوم على دولتين، لكن اللوبي الصهيوني في الإيباك لا يقبل بذلك.
و64 في المئة من الصهاينة داخل فلسطين المحتلّة يُلحّون على حكومة كاديما المتهرئة على أن تتفاوض مع حركة حماس لكنها لا تستجيب. فأي خلل هذا القائم بين خيارات الحكم وخيارات الناس في دولتين يعتقد جازماً أنهما ديمقراطيتان؟! وإيران ليست استثناءً لكي يقول غير ذلك.
إبراهيم يزدي يسكن في بلد عاش من الظروف ما لا تستحمله ذاكرة كثير من البلدان. لكنه لم يسمع (كما أننا أيضاً لم نسمع) أن طَبّقت بلاده الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ في شوارعها حتى أثناء حربها مع العراق.
هو يشيح بوجهه عن ذلك ليقبل من دولة ديمقراطية كبرى حين تُلغَي الانتخابات العامة فيها ثم تُلغِى الانتخابات الحزبية، وتقوم الحكومة الفدرالية (ولمدة عشر سنوات) بتولّي وظائف حكومات الولايات لستة وثلاثين مرة، وقبلها وبعدها باثنين وعشرين مرة! أليس هذا غريباً؟!.
إبراهيم يزدي لا يرى أي شيء جميل في بلاده. حتى النازيون قال عنهم الألمان لاحقاً إنهم متّنوا الاقتصاد ووسّعوا من الصناعة والسدود والجسور والأنفاق وعبَّدوا الطرق ومدوا السكك الحديد وزرعوا القمح وألغوا معاهدة فرساي، وأبدعوا في أولمبياد 1936. لكن إبراهيم يزدي لا يري أن شيئاً جيداً في بلاده!.
قد يعيب يزدي على حكومة الثورة تنميط علاقاتها السياسية بالسلب مع الولايات المتحدة الأميركية. لكنه لا يجتهد في البحث عن أسباب ذلك. هل سَمِع يزدي بقانون مقاطعة الاستثمار الأميركي «داماتو» الذي يحظر على الشركات الأجنبية استثمار أكثر من 40 مليون دولار في قطاعي النفط والغاز الطبيعي في إيران؟.
هل سَمِعَ بالضغط الأميركي على روسيا والصين لوقف تعاونهما مع إيران؟ والضغط على أوروبا واليابان والعالم العربي وآسيا الوسطى ودول القوقاز لتقليص تعاونهم معها وتقييدهم بشروط؟.
هل سَمِعَ بالضغط الأميركي على تركيا لإيقاف اتفاق الغاز المُسال بينها وبين طهران؟. هل سَمِعَ بالحملات الإعلامية الأميركية المُكثّفة بشأن المخاطر الناجمة عن قدرات إيران الصاروخية والعسكرية والنووية؟.
هل سَمِعَ بتشغيل الشبكات التلفزيونية والإخبارية الفارسية الموجّهة ضد إيران من صحراء كاليفورنيا ولوس أنجليس والتي يُموّلها الكونغرس الأميركي كإذاعة «فري يوروب/راديو ليبرتي» و «إذاعة فاردا» وشبكة «إن.إي.تي.في»؟.
وهل سَمِعَ يزدي بإلغاء الحظر الأميركي على تصدير الأسلحة إلى بعض الدول لخلق توازن جديد في آسيا الوسطى ضد بلاده، ثم العمل على مد حلف الناتو بهدف فصل إيران من الشمال والشمال الشرقي عن كل من روسيا والصين، والتغلغل الأميركي في أذربيجان وأوزبكستان بهدف التواجد العسكري بالمنطقة وتوتير أية تسوية لبحر قزوين؟.
هل سَمِعَ بتشريع الكونغرس الأميركي لدعم مرسوم تنفيذي رئاسي عالي السريّة لتمويل العمليات السرية ضد إيران ودعم القوى المناكفة لها بهدف زعزعة استقرار نظامها بقيمة 400 مليون دولار؟.
لا أظنّه يجهل كل ذلك وخصوصاً أنه قد يُبرّر لدانييل أورتيغا في نيكاراغوار ولرافاييل كوريا في الإكوادور عداءهما للولايات المتحدة بسبب التدخلات الأميركية المتكررة في بلدان القارة النُحاسيّة، لكنه لا يُبرّر لبلاده ذلك.
على أيّة حال. قد يُكثر إبراهيم يزدي من نقده للسياسات الإيرانية ما دامت الانتخابات الرئاسية قريبة، والتي قد يدخل فيها الإصلاحيون من تحت عباءة عبد الله نوري أو حتى خاتمي إن شاء الدخول. لكنه بالتأكيد سيستمر في نقده لأنه القوت الجيد للبقاء بالنسبة له.


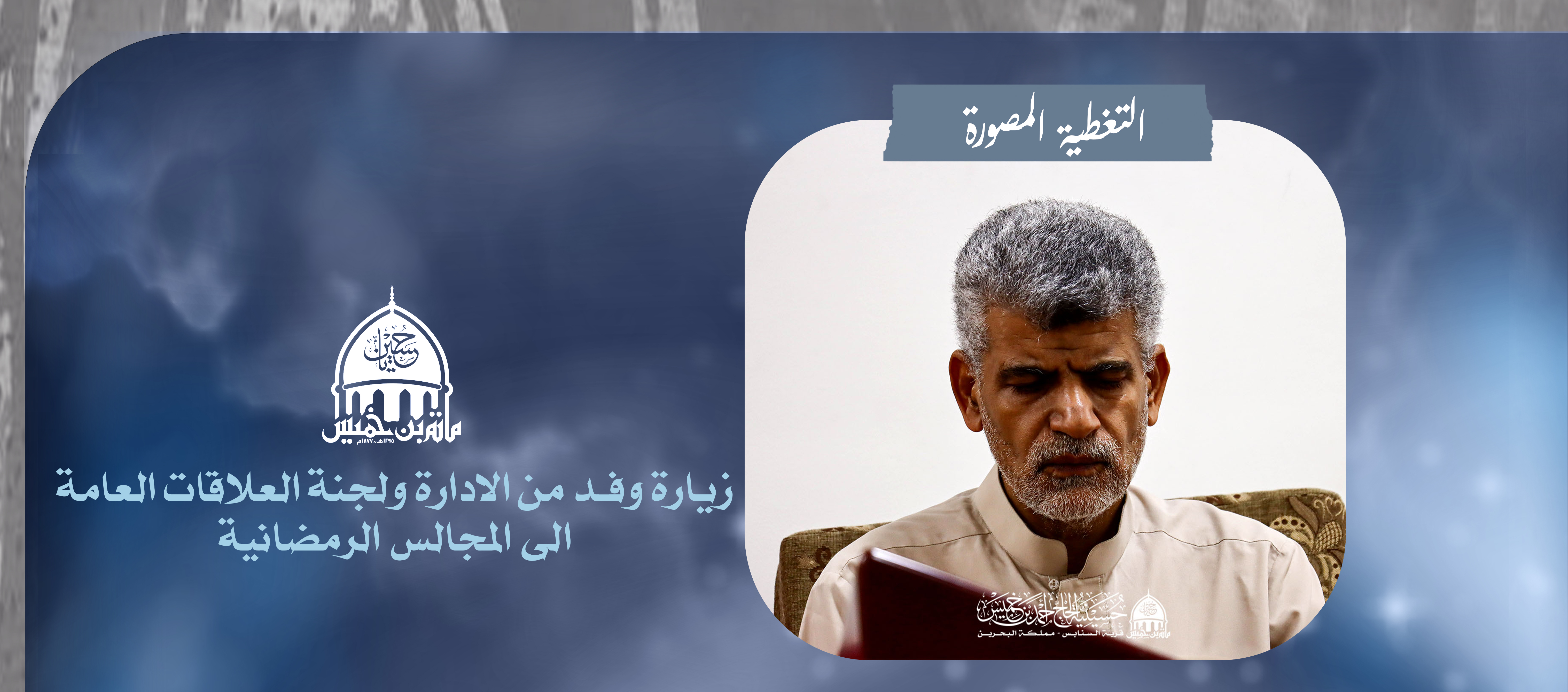

التعليقات (0)