كيف يمكن أن يأخذ الكتاب حيزاً في مكتبة الأسرة؟ وكيف يمكن أن ينمي الأهل حبَّ القراءة عند أولادهم؟
وأي كتب يمكن أن توضع على رفوف مكتبة العائلة؟
وكيف تصبح القراءة لذةً ورحلة بين الكلمات والسطور والصفحات يستمتع بها الأبناء والعائلة بشكل عام؟ أسئلة تطرح ونحن نعيش في أجواء تنظيم العديد من المعارض والمؤتمرات عن الكتاب والقراءة في ظل عصر العولمة المعرفية والمعلوماتية.
القراءة تشكل جسراً لعوالم متنوعة، للتاريخ والحاضر والمستقبل. هي رصد للعديد من الأفكار وإصغاءٌ لأصداء ولأصوات تتردد في فضاءات النص والكتب والمعاني.
والقراءة ارتباط بين القارىء والمقروء بين الكتاب والمتلقي له والمتصفح لصفحاته.
والأسرة تلعب دوراً مهماً في تنمية هذا الشغف بالقراءة وسبر غور الثقافة العامة أو المعرفة المتخصصة. فالأب القارىء أو الأم القارئة يؤثران تأثيراً بالغاً في الولد عندما يتعود على هذا المشهد اليومي للعلاقة بالكتاب والمطالعة.
هنا يبدأ التأسِّي بهما والانفتاح على عالم الكتاب وما فيه، مع ضرورة الارشاد المتوازن لنوعية الكتب المختارة، لا سيما وأن العثور على كتاب قيم ومهم ليس بالشيء السهل في ظل الكم المتراكم من المؤلفات.
هنا نشير إلى ضرورة تشجيع الأهل أيضاً للأبناء على شراء الكتب الضرورية لهم خصوصاً أثناء إقامة وتنظيم معارض الكتب السنوية أو من خلال المكتبات، مع الحفاظ على التنوع في الاختيار بما يتلاءم والثقافة الأفقية والعامودية معاً.
صحيح أنَّ التربية القرائية ضعيفة في مجتمعنا وهذا الأمر يقع على عاتق الأهل والمدرسة معاً لتفعيل هذه الظاهرة من خلال تبادل الكتب بين الطلبة أو الأقارب أو اجراء مسابقات لعرض وتلخيص بعض الكتب المهمة. أيضاً التقليل من زحمة الدروس والقراءات المدرسية وإعطاء فسحة من الوقت للمطالعة الخفيفة أو المكثفة في أوقات معينة.
على صعيد الأهل يمكن لهم إجراء مناقشة أسبوعية حول كتاب معين يطلع عليه الأبناء خلال أوقات فراغهم أو مناقشة شهرية فهذا يؤصل فكرة المطالعة ويعطيها بعداً جماعياً عائلياً جميلاً.
إنَّ فن التعامل مع الكتاب يحتاج لوقتٍ حتى نكسبه وإذا كسبناه يصبح عادة متأصلة فينا تنعكس على تعاملنا مع أي كتاب، هذه الكنوز البسيطة تحمل بين طياتها وصفحاتها معارفَ وعلومَ ومعلومات وثقافات وذهنيات كُتَّابها وما زال اقتناء الكتاب مسألة ضرورية للكثيرين.
ولا ننسى أنَّ للقلم ميزة تختلف عن غيره، فبه أقسم اللَّه تعالى: ن والقلم وما يسطرون هذا هو القلم وبالتالي هناك القراءة لما يبثه القلم من مراد، حتى أنَّ القراءة ورد فيها وعنها الكثير وهنا نستشهد بالآية القرآنية إقرأ باسم ربك الذي خلق.. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
فالإسلام دين العلم الذي يرتقي بالإنسان من درجات الجهل إلى علو مقام المعرفة، وهنا نستحضر قول الرسول (ص): اطلبوا العلم ولو بالصين.
بهذا الوعي للعلم والمعرفة وللكتاب والقلم، نصبح مجتمعاً قارئاً وبالتالي كاتباً ومؤلفاً في شتى مجالات الحياة والابداعات وفي ظل كافة التحديات والمواجهات الفكرية والثقافية فالثقافة بناء متكامل يبدأ بالقراءة والاطلاع ثم التدبر والفهم لما بين سطور الكلمات وبعد ذلك المشاركة في التوجيه والتخطيط، والنقد الموضوعي لما يُقرأ ولما يروج له بين الحين والآخر عبر الكتب أو عبر وسائل أخرى من وسائل المعرفة والمعلومات.
ولا ننسى أنَّ الأسرة هي حجر الأساس لأي مجتمع فالأهل لهم تأثيرات وراثية وبيئية وسلوكية وعندما يكونون قدوة لأولادهم في قراءة ما هو مفيد، قد يزرعون فيهم بذرة التأليف والكتابة وليس فقط القراءة والمطالعة، فقد قيل: <<إنَّ الشطر الأكبر من وقت الكاتب ينفق في المطالعة من أجل أن يكتب، وإن المرء قد يقلِّب نصف مجلدات المكتبة لكي يؤلف كتاباً.
وقيل أيضاً: <<قبل أن تكتب تعلَّم أن تفكِّر، وعن أمين نخلة ورد قوله: لأَن أخوضَ حرباً أسهل علي من أن أكتب مقطعاً نثرياً أنيقاً>> إذن القراءة والمطالعة في مكتبة العائلة وبين حنايا الوالدين وإرشادهما سبيل الابداع والكتابة وتخريج نماذج مؤلفين يحملون فكراً أو رسالة يلعبون دوراً على الصعيد الفكري والثقافي والنقدي في المجتمع الذي يعيشون فيه.
مع ضرورة ملاحظة أمر مهم هو أن الثقافة تحدد سلوك الفرد وهي أي الثقافة تبقى فينا بعد أن ننسى ما درسناه.
لذا فإنَّ تربية أولادنا على تحصيل الثقافة اللازمة لهم في الحاضر والمستقبل وتأهيلهم ليكونوا فاعلين في عملية التفاعل الثقافي والانتاج الفكري هي أجمل خدمة نقدمها إلى مجتمعنا والحياة من حولنا.
وهنا قالوا: ربُّوا الفرد يتربَّ المجتمع.
وهنا نذكر إشكالية مطروحة على صعيد مجتمعاتنا العربية تتلخص في زعم البعض أن العقلية العربية ليست لديها عدة معرفية كافية لمواجهة تعقد عصر المعلومات سواء على مستوى القضايا العامة أو المسائل المتخصصة بعدما تعددت الفروع المعرفية المغذية لعلم الثقافة، وهذا يتطلب سنداً معلوماتياً قوياً لإقامة الخرائط الثقافية والمعلوماتية وهنا ندرك ما يطرح من اشكاليات وتحديات وتهم ترمى في ملعبنا، ما يجعل الأمر يتجاوز الفرد إلى الجماعة والمجتمع بكامله، لن نستطيع أن نرد على هذه الاشكالية بشكل مفصل لضيق المساحة الخاصة بها ولأنَّ موضوعنا لا يتمحور حولها بشكل خاص. لكننا نقول إن العقلية الإسلامية قائمة على أسس متينة جداً مبنية من عقيدة ومفاهيم وشريعة ركزت على العقل ومكانته ودوره عند الإنسان وأقامت جسراً كبيراً وسميكاً بين الإنسان والعلم الذي لا حدَّ له بل يمتد من المهد إلى اللحد وليس أمام تحصيله حاجز حتى لو كان في الصين كما جاء عن الرسول (ص).
ولكن تزداد المسؤولية على المنتمين لهذه العقلية، وللمجتمع الإسلامي والعربي وللأسرة بالتحديد، لتخريج جيل يعلم كل هذه الاشكاليات ويتقن لغة العصر وأولها الاطلاع على ما يجري ويكتب ويطرح بين طيَّات الكتب وعبر وسائل المعرفة الحديثة والوسيط الالكتروني، والقراءة معرفة وحوار واطلاع وتتلمذ على سعة ما يقرأ والتبحر بالسطور وما بينها، ليصبح الواقع واضحاً أمامهم، من أجل المشاركة في صنع المستقبل والتفاعل مع الحاضر بطريقة متوازنة وحرَّة.
والأسرة مدخل حقيقي لفهم ما يجري من خلال تركيز علاقتها وعلاقة أبنائها بالاطلاع أو المطالعة والانخراط في منظومة الثقافة والمعلومات القائمة على قواعد وضوابط وتفاعل مع الأخذ بعين الاعتبار ثنائية التلقي والارسال وليس التلقي فقط الارسال المتمثل بفهم ما يُتلقى وعرضه على العقل المتدبر والناقد بموضوعية.
وهنا يتم تجاوز حدود التلقي ومجرد التذوق المعرفي ليصبح هناك توليد للمعرفة ويتحقق التكامل المعرفي والثقافي القائم على:
التعقل الظاهر.
التعقل الباطن.
وتعقل الابداع أو عقل الابداع.
هنا تكمن الصلة بين الاطلاع أو المطالعة الثقافية المتلقية والقدرة على التمحيص والتدقيق والربط ومن ثم الابداع.
لقد قيل سابقاً وتحديداً على لسان أرسطو عن الشعر أنه أي الشعر لا يقص علينا ما حدث، بل ما كان ممكناً أن يحدث، وهذا توليد للممكن، وهذا ينطبق على الثقافة العامة والقراءة والتأليف والمشاركة في صوغ معالم المجتمع الذي نعيش فيه أو الذي يختلف عنا، والمساهمة في التوزيع والتأثير والنشر وليس الاندماج فيما يوزعه المحتكرون للثقافة والمعلومات حتى لا نكون سلعة تباع وتشترى.



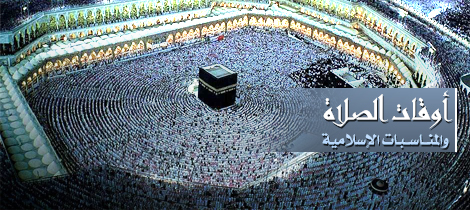
التعليقات (0)