إن المنع عن تدوين حديث النبي (صلى الله عليه وآله) هذه الواقعة تتمثل بنهي عمر عن تدوين الحديث والمنع عن كتابته، هذه الواقعة حصلت على أيديهم جاءت لتضعف فرضية أهل السنّة.
وقضية المنع هي واقعة تاريخية. فلو لم نرد أن نتحدث عنها من موقع كوننا شيعة تصدر من نوايا خاصة، بل وضعنا أنفسنا مكان أحد المستشرقين الأوربيين، فتحررت نظرتنا من قيد الانتماء إلى الشيعة أو السنّة، فإن غاية ما يصل إليه ذلك المستشرقين، وهو يصدر من أقصى مواقع حسن الظن، أن عمر - وهو ينطلق من قناعة في أن القرآن هو المرجع الوحيد (حسبنا كتاب الله) - قد منع الأمة من مزاولة الحديث وتدوينه لأن كثرة عودتها إليه تقضي إلى إضعاف عودتها لكتاب الله.
هذه الواقعة - كما ذكرنا - هي من ثوابت التاريخ، ولا تختص بنا نحن الشيعة.
ففي زمن عمر لم يكن أحد يجرؤ على كتابة الحديث، كما لم يكن أن يجرؤ على التصدي لروايته عن النبي (صلى الله عليه وآله) (لا شك أن نقل الحديث لم يكن ممنوعا) وقد استمر الحظر على التدوين حتى عهد عمر بن عبد العزيز الذي دامت خلافته ثلاث سنوات (99 - 101 هـ) حين تم تجاوز هذه السنّة العمرية وبدأ تدوين الحديث.
لقد بادر الذين كانوا يحفظون الحديث في صدورهم صدراً عن صدر، لرواية ما عندهم، فكُتب ودُوِّن. وقد قاد هذا المسار إلى أن يضيع قسم من أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله).
وعندما نطلّ على الواقع من جهة أخرى نجد أن الأحكام التي بينها القرآن، هي أحكام مختصرة جدا ومجملة. فالقرآن جميعه كليات. فمع عظيم تأكيده على الصلاة - مثلا - نجد أنه لم يتجاوز بشأنها أكثر من قوله: أقيموا الصلاة، مكتفيا بذكر السجود والركوع، من دون أن يتوفر على ذكر كيفية إقامتها. وكذا الحال بالنسبة لفريضة الحج، فمع ما تنطوي عليه إقامة الحج من أحكام عمل بها النبي (صلى الله عليه وآله)، لم نجد القرآن يبين شيئا منها.
وسنّة النبي أيضاً جاءت عملياً بهذه الصيغة العامة المجملة. وحتى ولو لم تكن كذلك، فكم يا تري كانت الفرصة التي توفرت للنبي (صلى الله عليه وآله) حتى يستطيع أن يبين فيها الحلال والحرام ؟ ففي السنوات الثلاث عشرة التي أمضاها في مكة، لم يكن يتجاوز عدد المسلمين- ربما - أربعمائة مسلم على الأكثر، وذلك في ظل أجواء الضغط والحصار التي كانت مفروضة هناك. وفي مثل هذه الأجواء لم يكن يتاح للمسلمين اللقاء بالنبي إلا خفية، بالإضافة إلى توجه سبعين عائلة منهم - هم نصف عدد المسلمين وربما أكثر - صوب الهجرة إلى الحبشة.
هذا هو واقع النبي (صلى الله عليه وآله) في مكة وما يتيحه هذا الواقع من فرص. أما في المدينة، فالفرصة وإن كانت متاحة على نحو أفضل، إلا أن مشكلات النبي كانت كثيرة أيضا.
وإذا أردنا أن نغض النظر عن الواقع الكائن في مكة والمدينة، ونفترض أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سلك في هذه السنوات الثلاث والعشرين من البعثة، نهج المعلم الذي لا شأن له إلاّ الذهاب إلى الصف وتعليم الناس، فمع ذلك لم يكن هذا الوقت وافياً كي يبين النبي للناس جميع ما ينطوي عليه الإسلام، فكيف إذا أضفنا لذلك، التاريخ القائم [الذي امتص جل أوقات النبي] خصوصا بشأن دين كالإسلام، يبسط حاكميته على جميع شؤون حياة البشر.
أفضى هذا المنطق الذي آمن به أهل السنّة إلى أن تبدو لهم النواقص واضحة عمليا في أحكام الإسلام. فعندما تطلّ عليهم مسألة ولا يلتمسون لها في القرآن حكما شرعيا. يرجعون إلى السنّة - بذاك القدر الذي نقلوه - فلا يعثرون فيها على حكمٍ شرعي أيضاً.
وعندئذ هل يصح ترك المسألة بلا حكم؟ وإذا كان الجواب بـ (لا)، فماذا يجب أن يُفعل ؟ أجابوا: القياس. والقياس يعني الاعتماد على مواطن التشابه بين ما له حكم في القرآن أو السنّة، وما ليس له فيهما حكم، فإذا تشابه الموردان قيس ما ليس له حكم على ما له حكم، وعرف حكمه على هذا الأساس.
على سبيل المثال، يظن في حكم جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه صدر عنه بهذا المناط والعلّة والفلسفة، فكلّما قُدّر وجود الفلسفة ذاتها في مورد آخر، حُكِمَ عليه بالحكم نفسه، على أساس ذلك الظنّ.
لم تقتصر مواطن الفراغ على قضية أو أثنتين. فالعالم الإسلامي كان يتوسّع، خصوصا في زمن العباسيين ، فقد فتحت البلدان، وازدادت الاحتياجات التي أخذت تستتبع مسائل جديدة. وعندما نظر أصحاب هذا الاتجاه إلى القرآن والسنّة، لم يجدوا فيهما جواباً على مسائلهم، لذلك بادروا لممارسة القياس. ومع ذاك فقد انقسموا إلى فريقين، أحدهما أنكر القياس كما هو عليه أحمد بن حنبل، ومالك بن أنس الذي قيل عنه أنه لم يمارس القياس في جميع سني عمره إلاّ في مسألتين. أما الفريق الثاني فقد فتح الباب أمام القياس واسعاً، وقد ذهب في ممارسته إلى عنان السماء، كما حصل مع أبي حنيفة. فأبو حنيفة لم يكن يعتقد أن ما بين الناس من سنن قد صدر عن النبي فعلا، لذلك لم يكن يثق بها، حتى قيل إنه لم يثبت لديه أكثر من (15) حديثا مما رووه عن النبي والبقية لم تثبت. بإزاء واقع كهذا، كان يستكمل بقية - الفراغات والمسائل- بممارسة القياس.
أما الشافعي فقد عبّر عن موقع وسط بين الفريقين، إذ كان يعتمد على الحديث في بعض الموارد، وعلى القياس في موارد أُخرى.
وهكذا آل الأمر إلى أن يظهر إلى الوجود فقه عجيب في خليطه ومكوّناته.
وممّا ذكروه بهذا الشأن أن أبا حنيفة أضحى قيّاساً لكونه فارسي الأصل من جهة، إذ عرف عن الإيرانيين توجّه أذهانهم أكثر نحو المسائل العقلية، ولسكنه العراق من جهة ثانية، وكونه بعيداً عن المدينة مركز أهل الحديث.
كان أبو حنيفة يمارس القياس بكثرة ويطلق لخياله العنان في هذا المضمار، حتى بلغ الأمر أن كتَب أهل السنّة: أن أبا حنيفة ذهب إلى الحلاق يوماً، حيث كان الشيب في أوّل أوانه، ولم يزدد في رأسه بعد، فطلب من الحلاق أن يستأصل الشعرات البيض لكي لا تزداد. فذكر له الحلاق أنّ الشعر الأبيض يزداد – باستئصاله - كثرة ونموّاً. فطلب منه أبو حنيفة أن يستأصل الشعر الأسود، وقد صدر موقفه هذا عن قياس فحواه: إذا كان الشعر الأبيض يزداد وينمو بالاستئصال، إذن من شأن الشعر الأسود أن يزداد ويكثر نموه بالاستئصال أيضا. في حال أن قاعدة نمو الشعر وازدياده بالاستئصال تنطبق على الشعر الأبيض فقط ولا تجري في الشعر الأسود. على هذا المنوال كان أبو حنيفة يمارس الفقه.
موقف الشيعة من القياس
عندما نرجع إلى روايات الشيعة، نلمس أنها تضرب جذور هذا التفكير ومرتكزاته ببيان خطأ التفكير الذي يذهب لعدم كفاية الكتاب والسنّة. والعودة إلى القياس تنشأ من التصوّر بعدم كفاية الكتاب والسنّة في بيان الأحكام الشرعية، فمع القول بعدم كفايتهما يصار لممارسة القياس.
في حين إن ما وصل عن النبي من السنّة بصيغة مباشرة، أو بصيغة غير مباشرة من خلال أوصيائه، تغني مراجعة كلياته عن اللجوء إلى القياس.
هذه هي روح الإمامة من وجهة نظر الدين. وليس الإسلام مسلكا وحسب، ليقول مُبتكر هذا المسلك (الاتجاه) بعد ظهور أيديولوجيته، إن هذا الاتجاه بحاجة إلى حكومة، فما هو الموقف من الحكم؟ كلا، بل يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار أن الإسلام دين، وهو بعد ذلك دين أبدي وشامل.


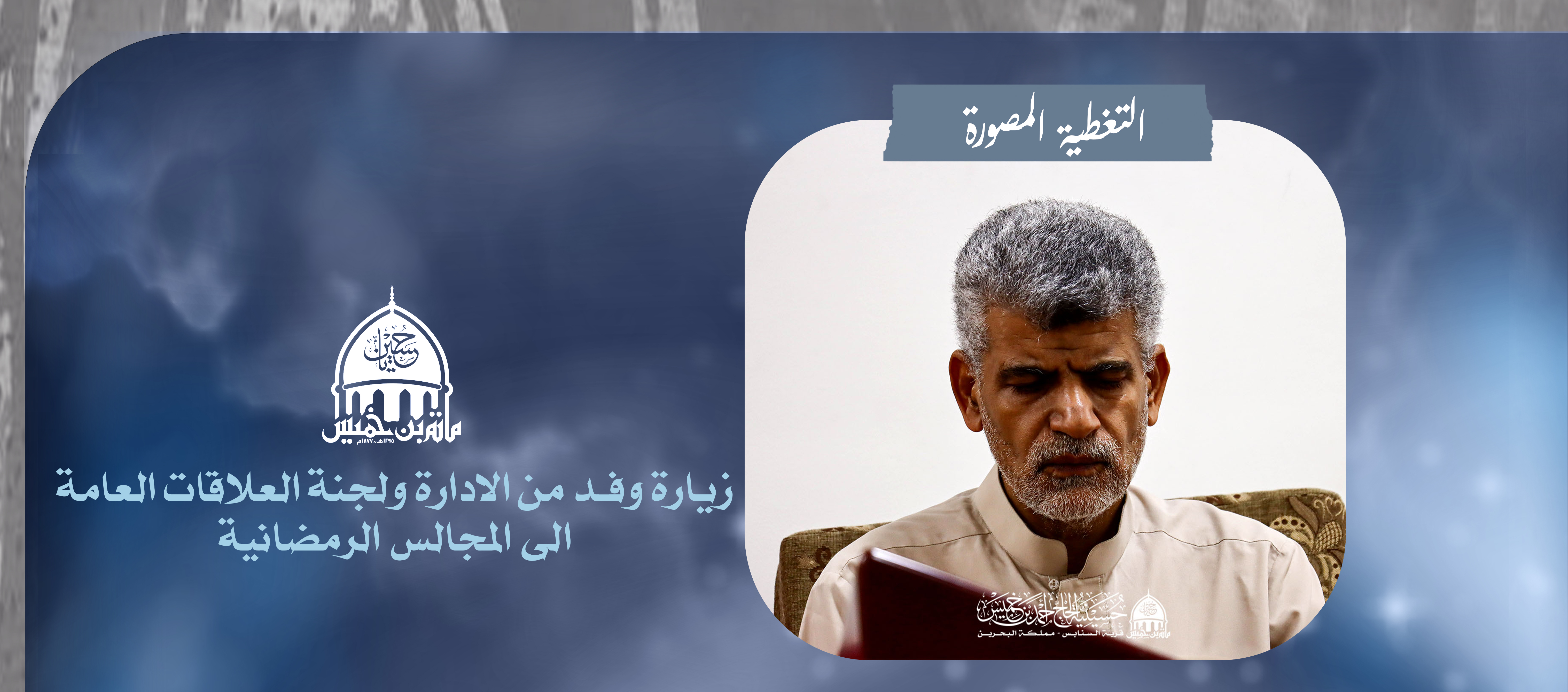

التعليقات (0)