تميزت مدرسة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) على المذاهب الأخرى في عصره بحرية الرأي والبحث فكان ذلك من أهم أسباب انتشار المعارف الجعفرية وذيوعها.
وقد رأينا فيما تقدم أن المذهب الكاثوليكي بقي طوال ألف سنة في حالة من الركود والافتقار إلى النشاط الفكري، وأن المذهب الأرثوذكسي لا يختلف اليوم عما كان عليه في القرن الثاني الميلادي في أنطاكية.
ولكن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أرسى للثقافة والمعارف الشيعية أساساً هيأ لها أسباب الذيوع والانتشار قبل نهاية القرن الثاني الهجري، بل لقد أصبحت هذه الثقافة نموذجاً لحرية الرأي والبحث، فاقتدت الفرق الإسلامية الأخرى بالشيعة في المباحث الكلامية والعلمية.
ويتوهم البعض بأن حرية البحث عند الشيعة مقتبسة من مدرسة الإسكندرية، في حين أن الواقع يختلف عن ذلك، ففي مدرسة الإسكندرية التي امتد نشاطها إلى القرن السابع الميلادي، وانهارت عند غزو العرب لهذه المدينة، كانت حرية البحث تقتصر على المباحث الفلسفية دون سواها، ولا تتعرض للمسائل الدينية، وأحياناً لمسائل علوم الفلك والفيزياء والطب والصيدلة.
وكانت أمور الدنيا محظورة فيها حظراً باتاً، صحيح أن بعض علماء مدرسة الإسكندرية كانوا من اليهود أو من المسيحيين، ولكنهم كانوا معرضين عن تناول المسائل الدينية في مباحثهم الفلسفية والعلمية، ومن هنا صارت مدرسة الإسكندرية مدرسة علمانية مجردة.
ولسنا في حاجة إلى سرد تاريخ مدرسة الإسكندرية، فالمعروف أن النشاط العلمي في الإسكندرية بدأ مع تأسيس مكتبتها الشهيرة على يدي بطليموس الأول ملك مصر الذي توفي سنة 258 قبل الميلاد وهو رأس أسرة ملوك البطالسة الذين حكموا مصر قرابة قرنين ونصف قرن، وهؤلاء على الرغم من أنهم من أصل يوناني، وكانوا يعبدون آلهة اليونان فإنهم لم يحاولوا حمل مدرسة الإسكندرية على قبول عقيدتهم الدينية وهم ملوك مصر.
وكان بيرون من أوائل علماء مدرسة الإسكندرية وفلاسفتها الذين اشتهروا باسم (الشكاكين). ولئن لم يقم في الإسكندرية طوال الوقت، إلا أنه يعد من فلاسفة هذه المدرسة. ومن الآراء التي ذهب إليها قوله إنه ليست في العالم حقيقة مجردة، لأنه ما من نظرية علمية إلا جاءت نظرية غيرها تفندها وتدحضها.
ويقال إن حالة الشك والتردد التي اعترت بيرون لم تكن وليدة مدرسة الإسكندرية، وإنما كان سببها أن لديه استعداداً نفسياً لذلك، ثم إن حرية البحث والرأي في مدرسة الإسكندرية شجعته على انتهاج هذا السبيل والمجاهرة برأيه في إنكار الحقيقة. ولو أن البطالسة أثروا في مدرسة الإسكندرية تأثيراً دينياً، أو كان لهم فيها نفوذ ديني، لما جرؤ بيرون وأنصاره على المجاهرة بمثل هذه النظرية، لا سيما والبطالسة كانوا يؤمنون بأن آلهة اليونان حقيقة لا تقبل الشك. وأياً كان الأمر، فهذا بحث لا نريد التوسع فيه، وحسبنا أننا أثبتنا أن مدرسة الإسكندرية كانت مدرسة علمانية.
أما حرية البحث في أمور الدين، فقد بدأت في الإسلام بعصر الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) وبعد انتشار المذهب الجعفري.
وكانت المدرسة الجعفرية تتناول المسائل الدينية جنباً إلى جنب مع المسائل العلمية (الدنيوية)، ومع الوقت، أصبح علماء الجعفرية يناقشون المسائل الدينية والفكرية ويثبتونها بقوانين العلم ومبادئه.
وانتقلت هذه الطريقة في ما بعد من المذهب الجعفري إلى المذاهب الأخرى التي اجتهدت في إثبات قضاياها بالدلائل العلمية.
ومعروف أن الأديان السماوية كالإسلام والمسيحية واليهودية لم تكن في بادئ الأمر تعلن مبادئها وتحاول إثباتها بالدلائل العلمية والنواميس الثابتة. وحتى اليوم وبعد انقضاء أربعة عشر قرناً على الإسلام وعشرين قرناً على المسيحية وثلاثين قرناً على اليهودية فإن كثيرين من أتباع هذه الأديان يعتقدون بأن الدين لا يحتاج إلى براهين علمية لإثباته، لأن الدين يرتبط بالإنسان عن طريق القلب والعواطف، لا عن طريق الاستدلال العلمي.
وتتفق هذه النظرة مع نظرة الآباء الأرثوذكس، كما أن كثيراً من الآباء الكاثوليك يؤيدون الرأي القائل بفصل الدين عن العلم، وليس معنى هذا عندهم أن الدين ليس نظرية يمكن إقامة الحجج عليها بالعلم، ولكن معناه أن الأحكام والمبادئ الدينية تظل محتفظة بصحتها وقدسيتها حتى ولو برهنت عليها الأدلة العلمية، فجوهر المسيحية هو المحبة والنقاء، ولا حاجة إلى العقل أو المنطق للبرهنة على هذين الأمرين.
وهذا يعلل لنا سبب عزوف المدارس الدينية المسيحية التي تسمى (بالسيمنار) عن تدريس العلوم على مدى قرون طويلة، تسليماً منها بأن الدين شيء والعلم شيء آخر.
ودرجت المدارس الدينية في العصور الوسطى على تدريس الشريعة المسيحية ـ أو القانون (كانون ـ إلى جانب المواد الدينية التقليدية، وهو عرف ما زال متبعاً في المدارس الكاثوليكية. أما علوم الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات والهندسة والميكانيكا والطب والصيدلة، فكانت غريبة عن المدارس الدينية المسيحية، وظلت مجهولة منها طوال العصور الوسطى.
وكانت الفلسفة محظورة لشدة خطورتها ـ في رأي هذه المدارس ـ على العقيدة الدينية. وقد سبق الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) جميع المدارس الدينية عندما قرر، ولأول مرة في تاريخ الأديان والأمم تدريس هذه العلوم جميعاً، إضافة إلى الفلسفة، جنباً إلى جنب مع العلوم القرآنية والفقه الإسلامي.
وقد تولى الإمام الصادق (عليه السلام) بنفسه تدريس هذه العلوم، ولم يستبعد منها الفلسفة أو الحكمة أو العرفان، لأن هذه العلوم كانت تمثل المبادئ والمجادلات التي يستعان بها في إثبات حقيقة الله والكون، وهي علوم كانت قد وصلت فعلاً إلى المدينة.
ولكن هذا كله حدث قبل ابتداء حركة الترجمة والنقل، وقبل أن تنقل كتب اليونان من السريانية إلى العربية، ولا يستبعد أن تكون فلسفة اليونان قد انتقلت إلى المدينة عن طريق أقباط مصر من تلامذة مدرسة الإسكندرية أو من المعجبين بها وبالبحث الحر، وقد خصصنا هنا المعجبين بمدرسة الإسكندرية، لأن رجال الدين الأقباط عموماً لم يولوا الفلسفة اهتماماً كبيراً لانتمائهم إلى الكنيسة الأرثوذكسية التي تعد الفلسفة شديدة الضرر.
وأياً كان الأمر، فقد نهض هؤلاء الأقباط بدور هام في نقل الفلسفة وبعض العلوم الأخرى إلى المدينة. ولا نعرف في تاريخ العلوم في الإسلام من تناول الفلسفة قبل الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، وإن كانت الشيعة اهتمت في ما بعد بالفلسفة والمنطق، وأدخلتهما ضمن دروس المدرسة الشيعية، ومنها انتقلت هذه العلوم إلى المذاهب الأخرى.
وقد ابتدأ الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) بتدريس مبادئ الفلسفة أو أسلوب الاستدلال والجدل المنطقي، وكانت مباحث الفلسفة في مدرسته تتناول في بادئ الأمر آراء سقراط وأفلاطون وأرسطو ونظريتهم.
ومنذ أن أرسى الإمام الصادق (عليه السلام) مبادئ الفلسفة في مدرسته وقام بنفسه بتعليمها، فإن هذه المبادئ تعد من الدروس التقليدية في المدرسة الشيعية، وهكذا أصبحت الفلسفة باباً متميزاً من تراث الشيعة وثقافتهم، وهي تنفرد به عن سائر الفرق والمذاهب الإسلامية، وتضيف إليه (العرفان) الذي تحدثنا عنه في ما مر من كلام.
وقد عرفنا أن (العرفان) انحدر في بادئ الأمر من الشرق ومن الإسكندرية أيضاً، ولكن الإمام الصادق (عليه السلام) استطاع أن يخرج من هاتين المدرستين بنظرية عرفانية تتفق مع أصول الإسلام ومبادئ الفكر الشيعي، وكما سبق القول، فالعرفان الجعفري له شخصيته المستقلة عن عرفان المتصوفة في الشرق أو في الإسكندرية، فهو يقول بأن أمور الحياة الدنيا ينبغي أن ينصرف إليها من الاهتمام ما لا يقل عن الاهتمام المنصرف إلى أمور الأخلاق وتزكية النفس. وصفوة رأيه في هذا الصدد أن الدنيا مزرعة الآخرة، ومن حق من زرعها أن يجني ثمارها، ولن يجني المرء إلا ما زرعت يداه. فمن التزم بدينه وزكى نفسه وخلقه، فلا خوف عليه في العالم الثاني.
ولا محل أيضاً في عرفان الإمام الصادق (عليه السلام) للمغالاة التي تجد مثلها عند العرفاء أو المتصوفة الآخرين، ولا محل أيضاً للقول بوحدة الخالق والمخلوق.
والحق أن مجلس الإمام الصادق (عليه السلام) ومدرسته كانا يمثلان منبراً حراً لتلامذته ومريديه، لهم أن يسألوا، ولهم أن يعترضوا، ولهم أن يعبروا عن آرائهم وإحساساتهم بحرية تامة، كما أن من حقهم أن ينتقدوا آراء أساتذتهم، ولم يكن الإمام يفرض على تلامذته رأياً معيناً، ولا كان يطلب منهم الإذعان لرأيه، ومع ذلك، فقد كان الأمر ينتهي دائماً بإذعانهم، بالنظر إلى الأسلوب العلمي الذي كان الإمام يتوسل به للتدليل على رأيه بالحجة الناصعة والمنطق السليم والبيان الرائق.
وكان المترددون على دروس الإمام الصادق (عليه السلام) يعرفون أن الإمام لن ينفعهم مادياً، بل لعل غشيان مجلسه يعرضهم لتهديدات السلطة الأموية خارج المدينة في أيام الأمويين. فإن عرف عن أحد ولاؤه للإمام الصادق (عليه السلام)، لم يأمن على حياته من أعوان الخليفة، ذلك بأن الخليفة كان يعتبر الإمام وأنصاره من خصوم الخلافة، ومع إنه كان يعلم جيد العلم بأن الشيعة وأنــــصار الإمام لا يملكون من القوة ما يستطيعون به مقارعة حكمه، فقد كان يـعـــدهم خصوماً ألــــداء له.
وهكذا كانت المخاطر تحيط بمدرسة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) والمترددين عليها، وكان طلاب المدرسة يعلمون علم اليقين بأن الإمام لا يملك مالاً أو مناصب فيوزعها عليهم، فلم يجتذبهم إلى مدرسته، برغم هذه المخاطر وبرغم انعدام المنفعة المادية إلا إخلاص مستقر في النفس، وإيمان عميق في القلوب، وانجذاب لشخصية الإمام (عليه السلام)، وإعجاب بدروسه التي يلقيها ببيانه العذب ويستهدف بها الحقائق وجوهر المعرفة.
وكان الإمام الصادق (عليه السلام) يؤمن بما يقول، ويأخذ بالواقع لا بالمثاليات، ولهذا لم يتوسل أبداً في دروسه بأسلوب (البوتوبيا) الذي سيطر على تفكير المجتمع الأوروبي منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي، ومن هنا انتفت من دروس الإمام الصادق (عليه السلام) أي دعوة إلى قيام حكومة مثالية لا تتفق مع واقع الحياة في المجتمع البشري.
وإذا كان بعض من الطلاب الذين أخذوا العلم عن الإمام محمد الباقر (عليه السلام) طمعوا في الظفر ببعض الوظائف كمناصب القضاء في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك الذي كان يسمح بتعيينهم، فإن المترددين على مدرسة الإمام الصادق (عليه السلام) لم يداعبهم الأمل في الحصول على مثل هذه الوظائف، ولا على أي نفوذ سياسي، وإنما كانوا يغشون مجلسه للاغتراف من علمه فحسب.
وقد قلنا قبلاً إن مدرسة الإمام الصادق (عليه السلام) كانت متمتعة بحرية البحث أسوة بمدرسة الإسكندرية، ولكن هناك بوناً شاسعاً بين المدرستين في هذا الأمر. ففي حين أن مدرسة الإسكندرية أوصدت الباب دون مناقشة المسائل الدينية كما ذكرنا آنفاً، أباح الإمام الصادق (عليه السلام) في مدرسته حرية البحث في جميع الموضوعات، ومنها الدينية، ولم يكن ثمة حرج في أن ينتقد الطالب آراء أستاذه، أو أن يطرح عليه الأسئلة في ما يعن له.
وقد اغتذت الثقافة الشيعية من هذه الحرية التي هيأت لهذه الثقافة أسباب الذيوع والانتشار الواسعين، وأقبل عليها الراغبون في حرية البحث والاستدلال، كما أقبل عليها الموالون للشيعة مدفوعين إلى ذلك برغبة باطنية.
ومن يتصفح التاريخ قبل قيام الدولة الصفوية، يلاحظ أن الحكومات الشيعية التي قامت في البلاد الشرقية كانت معدودة، وأشهرها حكومة البوهيين، كما يلاحظ أن هذه الدول لم تتوسل بالقوة أو النفوذ السياسي لنشر المذهب الشيعي، وإنما اقتصرت على التمسك بالتقاليد والأعراف والمبادئ الشيعية، وفي مقدمتها الاحتفالات الدينية في أيام التعزية، وبصورة خاصة يوم عاشوراء عام 61 للهجرة الذي استشهد فيه الإمام الحسين بن علي (عليه السلام) في كربلاء، ولم يكتب لدولة شيعية أن تستقر طويلاً في بلاد الشرق بعد البوهيين، باستثناء دولة الفاطميين في غرب العالم الإسلامي، إلى أن قامت الدولة الصفوية في القرن العاشر الهجري (1502ـ 1736م).
ومع ذلك، أخذ التشييع ينتشر في ربوع الشرق بثقافته العلمية المنطقية المبسطة، بإصرار وثبات في مقاومة التيار الحكومي المعادي له، وإن لم ينجح في إنشاء مركز سياسي أو نظام حكومي يستند إليه، أي أنه نجح بالفكر لا بالسلطان، وبالروح لا بالقدرة المادية.
وفي التاريخ أقوام وطوائف أخرى عاشت دون أن تكون لها دول أو حكومات، ولكنها استندت إلى مكانة مستمدة من القدرة المادية، كاليهود مثلاً الذين عاشوا في أوروبا منذ العصور الوسطى. وبسبب غناهم، كان الناس يقترضون المال منهم ويردونه بأبهظ الفوائد الربوية. بل لقد وصل الأمر إلى حد أن بعض الملوك والأمراء استقرضوا منهم المال، وحظروا على الناس التعرض لهم بسوء نظراً لحاجتهم إليهم. فعاش اليهود مع المسيحيين في أوروبا في العصور الوسطى متمتعين بحرية تامة، وإن كانت مجموعات منهم آثرت الانطواء على نفسها، واستقلت بأحياء خاصة باليهود انزوت فيها مع أبناء العقيدة في بعض مدن أوروبا.
وبعدما تخلصت القارة الأوربية من متاعب العصور الوسطى وظلمات الجهل، عاشت ألف سنة بعد الإمام الصادق (عليه السلام) وهي لا تملك حرية الاعتراض في مسائل الدين، أو حتى التساؤل حولها، فإن حدث في دولة من دول أوربا اللاتينية (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال) أن سولت لأحد نفسه أن ينتقد موضوعاً من موضوعات المذهب الكاثوليكي، لنزلت به العقوبات الصارمة، فكيف به إذا جرؤ على انتقاد أصل من أصول الدين المسيحي؟ لقد قضي على القس الإيطالي (برونو) بالموت حرقاً، ولم يكن ذنبه إلا قوله إن الإنسان متى بلغ سن الرشد، تكونت لديه آراء تتفق مع عقله واستنباطه في شأن الحياة والدنيا، وعلى بساطة هذه النظرية وواقعيتها، انقض عليه المتزمتون والتقليديون، فرموه بالهرطقة والكفر، ثم قتلوه بإلقائه في النار حياً.
ومما يذكر أن القس برونو هنا ـ واسمه الكامل جيوردانو برونو ـ عاش في أواخر القرن السابع عشر، وكان عمره عند إحراقه في عام 1600 ميلادية 52 سنة. وقد أنفق حياته كلها في إغاثة الملهوفين ومساعدة الفقراء والمعوذين ومعالجة المرضى المعدمين، وكانت لذته الوحيدة إرهاق نفسه إسعاداً للآخرين وتخفيفاً لآلام المحتاجين، شأنه في ذلك شأن النحلة (الشغالة) التي تكد وتتعب في جمع الطعام لأترابها من النحل.
ويقال إنه كان يدع بابه مفتوحاً حيثما حل، ليطرقه من يشاء من السائلين ليلاً ونهاراً، وإنه كان يلبي كل حاجة معقولة للآخرين، ولم يكن يرفض لأحد طلباً أو سؤالاً، ولكن كل هذا لم يشفع لهذا القسيس المنتمي إلى الكنيسة الدومينيكية، فقتل شر قتلة.
وقد رسم الشاعر الفرنسي الأشهر (فيكتور هيجو) في كتابه المعروف (البؤساء) صورة قسيس من خيار رجال الدين، أطلق عليه اسم (بينونو) رامزاً بذلك إلى (برونو).
وفي اليوم المحدد لتنفيذ حكم الإحراق في برونو في الساحة الكبيرة لمدينة البندقية، جندت السلطة قوة عسكرية ضخمة لتحول بين المشاهدين وبين مكان تنفيذ الحكم.
وعندما علق (برونو) مصلوباً على خشبة الإعدام، وتحته كميات كبيرة من الحطب والمواد المحرقة، تعالى نحيب الواقفين وعويلهم، وانبعث صراخهم تلقاء هذا المنظر، فعجل الجلاد بإشعال النار للانتهاء من تنفيذ الحكم قبل أن تنفجر ثورة الفقراء والمعوزين احتجاجاً على هذا الحكم الفظيع، ووسط اللهب المتصاعد اختنق صوت برونو وانطفأت شعلة حياته، ولم ينقذه من هذا المصير المروع رصيده الباذخ في خدمة الإنسان والإنسانية.
كان هذا الحكم صادراً من محاكم التفتيش العقائدية اعتبرت برونو خارجاً على الدين لقوله إن الإنسان متى بلغ سن الرشد، كون لنفسه عقيدة حول الدنيا والحياة تتفق مع عقله واستنباطه. وفي رأي هذه المحاكم أن المسيحي متى بلغ سن الرشد، تقبل دون نقاش ما تصوره له الكتب المقدسة بعهديها القديم والجديد، ورفض كل ما يخالف ذلك من نوازع عقله وتفكيره.
وقيل في حكم المحكمة إن برونو خارج على الدين لأن الشيطان حل فيه، ولابد من إحراقه لإخراج الشيطان منه.
أما في الإسلام، فقد بلغت حرية الرأي والبحث في جميع أمور الدين والعلوم حداً أتاح لرجل مثل (ابن الراوندي) أن يظهر وأن يطالع الناس بآرائه الجريئة.



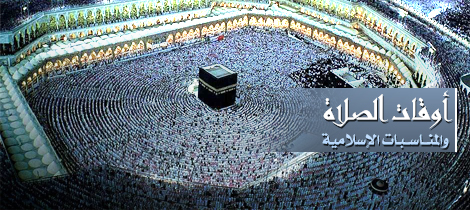
التعليقات (0)