
ما هي علاقة الإمام الجواد بالمأمون العباسي ومدى ارتباطه به، وسائر شؤونه معه، وكيف تمت المصاهرة بين الإمام الجواد والمأمون العباسي، يتناول هذا البحث هذه القضية وفيما يلي ذلك:
أوّل التقاء:
وجرى أوّل التقاء بين الإمام أبي جعفر (عليه السلام) والمأمون في بغداد، حينما كان المأمون خارجاً مع حاشيته في موكب إلى الصيد فاجتاز في الطريق على صبية فلما رأوه انهزموا خوفاً منه سوى الإمام الجواد، فبصر به المأمون فوقف يسأله عن عدم فراره، فأجابه (عليه السلام) بحكمة وتدبّر:
(ليس في الطريق ضيق حتى أوسعه لك، ولم أجرم فأخشاك منه، والظنّ بك حسن إنّك لا تضرّ من لا ذنب له..).
وبُهر المأمون من هذا المنطق الفيّاض فراح يسأله:
ما اسمك؟
محمد.
ابن مَن؟
ابن علي الرضا.
ولم يستكثر عليه المأمون هذا الذكاء المفرط، فهو من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومركز الوعي، والإحساس في الأرض، وترحّم المأمون على الإمام الرضا (عليه السلام) وانطلق في مسيرته نحو البيداء للصيد، ولمّا انتهى إلى موضع الصيد أرسل بازيّاً كان معه فغاب عنه، وبعد فترة عاد وفي منقاره سمكة صغيرة فيها بقايا الحياة، فتعجّب المأمون وقفل راجعاً إلى بلاطه، والتقى بالإمام الجواد (عليه السلام)، وبادره المأمون قائلاً:
(يا محمد ما في يدي؟..).
فأجابه الإمام: (إنّ الله تعالى خلق في بحر قدرته سمكاً صغيراً تصيده بازات الملوك والخلفاء، كي يختبروا بها سلالة بني المصطفى..).
ولم يملك المأمون إعجابه بالإمام فراح يقول: (أنت ابن الرضا حقّاً!!).
وأخذه معه، وأحسن إليه، وبالغ في إكرامه وكان هذا الاجتماع أوّل التقاء بين الإمام والمأمون.
زواج الإمام من ابنة المأمون:
وأجمع المؤرّخون على أنّ المأمون قد رغب في زواج الإمام أبي جعفر (عليه السلام) من ابنته أمّ الفضل، فهو الذي دعاه إلى هذه المصاهرة، ومن الجدير بالذكر أنّها ثاني علاقة تكون بهذا المستوى بين الأسرتين العلوية والعباسية بعدما انهارت جميع أسس العلائق والقرابة التي كانت بينهما، ولم يعدّ أي تقارب أو التقاء بين الأسرتين، وكان ذلك منذ عصر الطاغية اللئيم المنصور الدوانيقي، وجرى أبناؤه على ذلك فنكّلوا بالعلويّين كأفظع ما يكون التنكيل.
أسباب المصاهرة:
وذكر الرواة والمؤرّخون عدّة أسباب لإقدام المأمون على هذه المصاهرة وهذه بعضها:
1 - ما أدلى به نفس المأمون حينما عزم على أن يزوّج الإمام من ابنته فقال: (أحببت أن أكون جدّاً لامرأة ولده رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليّ بن أبي طالب (عليه السلام)).
وفيما اعتقد أنّ هذا ليس هو السبب الحقيقي في هذه المصاهرة، فإنّ المأمون لم يؤمن بقرارة نفسه في هذه الجهة، ولو كان صادقاً فيما يقول لما اغتال الإمام الرضا (عليه السلام) وما أوعز إلى جهاز حكومته بمطاردة العلويّين وقتلهم.
2 - إنّ الذي دعا المأمون إلى ذلك إعجابه بمواهب الإمام الجواد (عليه السلام) وعبقرياته التي أصبحت حديث الأندية والمجالس، وهذا الرأي لم يحظ بأي تأييد علمي.
3 - إنّه أراد التمويه على الرأي العام بإظهار براءته من اغتياله للإمام الرضا (عليه السلام) فإنّه لو كان قاتلاً له لما زوّج ابنه من ابنته.
4 - إنّه حاول الوقوف على نشاط الإمام الجواد (عليه السلام) والإحاطة باتّجاهاته السياسية، ومعرفة العناصر الموالية له، والقائلة بإمامته، وذلك من طريق ابنته التي ستكون زوجة له.
5 - لعلّ من أهم الأسباب، وأكثرها خطورة هو أنّ المأمون قد حاول من هذه المصاهرة جرّ الإمام إلى ميادين اللهو واللعب ليهدم بذلك صرح الإمامة الذي تدين به الشيعة، والذي كان من أهمّ بنوده عصمة الإمام وامتناعه من اقتراف أي ذنب عمداً كان أو سهواً، وكان من الطبيعي أن يفشل في ذلك فإنّ الإمام (عليه السلام) لم يتجاوب معه بأيّ شكل من الأشكال، ولو كان في ذلك إزهاق نفسه، أمّا ما يدلّ على ذلك كلّه فهو ما رواه ثقة الإسلام الكليني قال ما نصّه: (احتال المأمون على أبي جعفر (عليه السلام) بكلّ حيلة فلم يمكّنه فيه شيء، فلمّا اعتلّ وأراد أن يبني عليه ابنته دفع إلى مائتي وصيفة من أجمل ما يكون إلى كلّ واحدة منهنّ جاماً فيه جوهر يستقبلن أبا جعفر إذا قعد في موضع الأخيار، فلم يلتفت إليهنّ، وكان هناك رجل يقال له مخارق، صاحب صوت وعود، وضرب، طويل اللحية فدعاه المأمون، فقال: يا أمير المؤمنين إن كان شيء من أمر الدنيا فأنا أكفيك أمره، فقعد بين يدي أبي جعفر (عليه السلام) فشهق مخارق شهقة اجتمع عليه أهل الدار، وجعل يضرب بعوده، ويغنّي، فلمّا فعل ساعة وإذا أبو جعفر لا يلتفت إليه يميناً ولا شمالاً، ثمّ رفع إليه رأسه، وقال: اتّق الله يا ذا العثنون قال: فسقط المضراب من يده والعود، فلم ينتفع بيديه إلى أن مات، فسأله المأمون عن حاله قال: لمّا صاح بي أبو جعفر فزعت فزعة لا أُفيق منها أبداً.
وكشفت هذه الرواية عن محاولات المأمون لجرّ الإمام (عليه السلام) إلى ميادين اللهو، فقد عرض له جميع ألوان المغريات، وكان الإمام آنذاك في ريعان الشباب، فاعتصم (عليه السلام) بطاقاته الروحية الهائلة، وامتنع عمّا حرّمه الله عليه، وقد أفسد (عليه السلام) بذلك مخطّطات المأمون الرامية إلى إبطال ما تذهب إليه الشيعة من عصمة أئمتهم، وكانت هذه الجهة - فيما نحسب - هي السبب في إضفاء لقب التقي عليه لأنّه اتّقى الله في أشدّ الأدوار، وأكثرها صعوبة، فوقاه الله شرّ المأمون.
فزع العبّاسيّين:
وفزع العباسيون كأشدّ ما يكون الفزع حينما علموا أنّ المأمون قد عزم على مصاهرة الإمام الجواد (عليه السلام) فعقدوا اجتماعاً حضره كبارهم وذوو الرأي والمشهورة منهم، وعرضوا فيما بينهم خطورة الأمر، وما قد ينتهي إليه من نقل الخلافة والملك من العباسيين إلى العلويين، وبعد مداولة الحديث، ومناقشة الأمر من جميع جهاته، أجمع رأيهم على الاجتماع بالمأمون، وإبداء المعارضة التامّة لما أقدم عليه.
اجتماع العباسيّين بالمأمون:
وهرع إلى البلاط العباسي الأدنون من المأمون من العباسيين، وقد نخر الحزن قلوبهم وساد فيهم صمت رهيب، وانبروا إلى المأمون فقالوا له:
(ننشدك الله يا أمير المؤمنين أن تقيم على هذا الأمر الذي قد عزمت عليه من تزويج ابن الرضا، فإنّا نخاف أن تُخرج عنّا أمراً قد ملّكناه الله، وتنزع منّا عزّاً ألبسناه، فقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديماً وحديثاً، وما كان عليه الخلفاء الراشدون من تبعيدهم، والتصغير بهم، وقد كنا في وهلة من عملك مع الرضا ما علمت، حتى كفانا الله المهمّ من ذلك، فالله الله، أن تردّنا إلى غم قد انحسر عنّا، واصرف رأيك عن ابن الرضا، واعدل إلى ما تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره..).
ووضع العباسيون أمام المأمون النقاط الحسّاسة المثيرة للعواطف، فقد نبّهوه بأحقاد آبائه وعدائهم للعلويّين، وما صنعه بهم الخلفاء السابقون من تبعيدهم عن مراكز الحكم، وما صبّوه عليهم من صنوف التنكيل والتعذيب وليس له أن يشذّ عن سنّة آبائه وسيرتهم فإنّه يشكّل بذلك خطراً على أسرته، ولم يعن المأمون بذلك وراح يفنّد ما قالوه، قائلاً:
(أمّا ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيه، ولو أنصفتم القوم لكانوا أولى بكم، وأمّا ما كان يفعله من قبلي بهم، فقد كان به قاطعاً للرحم، وأعوذ بالله من ذلك، والله ما ندمت على ما كان منّي من استخلاف الرضا، ولقد سألته أن يقوم بالأمر، وأنزعه عن نفسي فأبى، وكان أمر الله قدراً مقدوراً، وأمّا أبو جعفر محمد بن علي قد اخترته لتبريزه على كافّة أهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سنه، والأعجوبة فيه بذلك، وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه، فيعلموا أنّ الرأي ما رأيت فيه..).
وندّد المأمون بالعباسيين فهم الذين قطعوا أواصر الرحم والقربى بينهم وبين العلويين، ولو أنصفوا نفوسهم، ورجعوا إلى حوازب أفكارهم لرأوا أنّ العلويين أولى بمقام النبي (صلى الله عليه وآله) ومركزه منهم لأنّهم ذرّيته وأبناؤه، ولأنّ هذا الدين قد بني بتضحياتهم وجهادهم، وأمّا العباسيون قديماً وحديثاً فليست لهم أيّة خدمة للإسلام ولا للمسلمين، وإنّما صنعوا ما أضرّ بالإسلام والمسلمين.
وعرض المأمون في حديثه إلى الإمام أبي جعفر (عليه السلام) فأبدى إعجابه البالغ به فهو الأعجوبة الكبرى الذي بزّ جميع أهل العلم والفضل، وتفوّق عليهم مع صغر سنه.
وانبرى العباسيون فطلبوا منه أن يؤجّل زواج الإمام حتى يكبر ويتفقّه في الدين قائلين:
(إنّ هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنّه صبي لا معرفة له، ولا فقه، فأمهله ليتأدّب، ويتفقّه في الدين، ثمّ اصنع ما تراه بعد ذلك..).
وردّ عليهم المأمون بما عرفه من واقع أهل البيت (عليهم السلام) قائلاً:
(ويحكم إنّي أعرف بهذا الفتى منكم، وإنّ هذا من أهل بيت علمهم من الله، ومواده وإلهامه، لم يزل آباؤه أغنياءً في علم الدين والأدب عن الرعايا الناقصة عن حدّ الكمال، فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبين لكم ما وصفت من حاله..).
إن المأمون لعلى بيّنة بأئمة أهل البيت (عليهم السلام) الذين آتاهم الله من العلم والحكمة ما لم يؤت أحداً من العالمين.
واتّفق المأمون مع العباسيين على امتحان الإمام الجواد (عليه السلام) لعلّه يعجز عن الجواب فيفسد بذلك مصاهرته للمأمون بالإضافة إلى أنّهم سيتّخذون من ذلك وسيلة لبطلان ما تذهب إليه الشيعة من أنّ الإمام أعلم أهل عصره وأفضلهم وانبرى العباسيون قائلين:
(قد رضينا لك يا أمير المؤمنين ولأنفسنا بامتحانه، فخلِّ بيننا وبينه لننصب من يسأله بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة فإنّ أصاب الجواب عنه لم يكن لنا اعتراض في أمره، وظهر للخاصّة والعامة سداد رأي أمير المؤمنين، وإن عجز عن ذلك، فقد كفينا الخطب في معناه..).
وانصرف العباسيون، وهم يفتّشون عن شخصيّة علمية تتمكنّ من امتحان الإمام وتعجيزه.
انتداب يحيى لامتحان الإمام:
وأجمع رأي العباسيّين على اختيار يحيى بن أكثم قاضي قضاة بغداد، وأحد أعلام الفقه في ذلك العصر، لامتحان الإمام أبي جعفر (عليه السلام)، وعرضوا عليه الأمر، ومنّوه بالأموال الطائلة إن امتحن الإمام وعجز عن جوابه، فإنّ يحقّق لهم أعظم الانتصارات، وأجابهم يحيى إلى ذلك، وانصرف إلى منزله، وراح يفتّش في كتب الفقه والحديث عن أعقد المسائل وأهمّها ليمتحن بها الإمام (عليه السلام) وانطلق العباسيّون إلى المأمون فعرّفوه باستجابة يحيى لهم، وطلبوا منه تعيين يوم لامتحان الإمام، فعيّن لهم يوماً خاصاً.
أسئلة يحيى:
ولمّا حضر اليوم المقرّر لامتحان الإمام (عليه السلام) هرع العباسيون إلى بلاط المأمون وحضر الاجتماع أهل الفضل وأعلام الفكر وسائر طبقات الناس وكان يوماً مشهوداً، وقد غصّت قاعة الاجتماع على سعتها بالناس، وأمر المأمون أن يفرش للإمام أبي جعفر (عليه السلام) دست، ويجعل له فيه مسورتان فصنع له ذلك، وجلس فيه الإمام (عليه السلام) وكان له من العمر تسع سنين وأشهر، وجلس يحيى بن أكثم بين يديه، وجلس المأمون في دست متّصل بدست الإمام (عليه السلام).
واستحال الجمع إلى آذان صاغية، وانبرى يحيى إلى المأمون فطلب منه أن يأذن له في امتحان الإمام فإذِن له في ذلك، واتّجه يحيى صوب الإمام وقال له:
(أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟..).
وقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً:
(سل إن شئت..).
ووجّه يحيى مسألته إلى الإمام قائلاً:
(ما تقول جعلني الله فداك في مُحرم قتل صيداً؟..).
وحلّل الإمام (عليه السلام) هذه المسألة إلى عدّة مسائل، وشقّقها إلى مجموعة من الفروع وسأل يحيى أي فروع منها أراد قائلاً:
(قتله في حلّ أو حرم، عالماً كان المحرم أم جاهلاً، قتله عمداً أو خطأً، حرّاً كان المحرم أم عبداً، صغيراً كان أم كبيراً، مبتدءاً بالقتل أم معيداً، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيره، من صغار الصيد أم من كبارها، مصرّاً كان أو نادماً، في الليل كان قتله للصيد أم نهاراً، محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحجّ كان محرماً..).
وذهل يحيى، وتحيّر، وبان عليه العجز إذ لم يتصوّر هذه الفروع المترتّبة على مسألته، وعلت في القاعة أصوات التكبير والتهليل، فقد استبان للجميع أنّ أئمة أهل البيت (عليهم السلام) هم معدن العلم والحكمة وإنّ الله منح كبارهم وصغارهم بما منح به أنبياءه من الكمال والعلم.
لقد شقّق الإمام (عليه السلام) هذه المسألة إلى هذه الفروع وإن كان بعضها لا يختلف فيه الحكم كما إذا كان القتل للصيد في الليل أم في النهار فإنّ الحكم فيهما واحد، وإنّما ذكر الإمام (عليه السلام) ذلك لتبكيت الخصم الذي سأل الإمام للامتحان لا للفهم.
وعلى أي حال فإنّ المأمون لما رأى العجز قد استبان على يحيى فلم يطق جواباً أقبل على بني العباس فقال لهم:
(الحمد لله على هذه النعمة، والتوفيق لي في الرأي.. أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه..).
واستبان لبني العباس فضل الإمام، وإنّه من عمالقة الفكر والعلم في الإسلام.
كما ظهر لهم صحّة ما قاله المأمون: إنّهم لا يعرفون أهل البيت (عليهم السلام).
مع ابن تيميّة:
وأنكر ابن تيميّة هذه الرواية، واعتبرها من الموضوعات - بغير أدب في التعبير - فقد علّق عليها بما نصّه:
(إنّ هذه الحكاية التي حكاها عن يحيى بن أكثم من الأكاذيب التي لا يفرح بها إلاّ الجاهل، ويحيى بن أكثم أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص بأن يسأله عن محرم قتل صيداً، فإن صغار الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة، فليست من دقائق العلم وغرائبه، ولا ما يختصّ به المبرّزون في العلم، ثمّ مجرّد ما ذكره ليس فيه إلاّ تقسيم أحوال القاتل ليس فيه بيان حكم هذه الأقسام، ومجرّد التقسيم لا يقتضي العلم بأحكام الأقسام، وإنّما يدلّ إن دلّ على حسن السؤال، وليس كلّ من سُئل أحسن أن يجيب.
ثمّ إن كان ذكر الأقسام الممكنة واجباً فلِمَ يستوف الأقسام، وإن لم يكن واجباً فلا حاجة إلى ذكر بعضها، فإنّ من جملة الأقسام أن يقال: متعمّداً كان أو مخطئاً، وهذا التقسيم أحقّ بالذكر من قوله: عالماً كان أو جاهلاً، فإنّ الفرق بين المتعمّد والمخطئ ثابت بالإثم باتّفاق الناس، وفي لزوم الجزاء في الخطأ نزاع مشهور، فقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنّ المخطئ لا جزاء عليه، وهو أحد الروايتين عن أحمد، قالوا: إنّ الله قال: (ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم) فخصّ المتعمّد بوجوب الجزاء، وهذا يقتضي أنّ المخطئ لا جزاء عليه، لأنّ الأصل براءة ذمّته، والنصّ إنّما وجب على المتعمّد، فبقي المخطئ على الأصل، ولأنّ تخصيص الحكم بالمتعمّد يقتضي انتفاءه عن المخطئ فإنّ هذا مفهوم صفة في سياق الشرط، وقد ذكر الخاصّ بعد العامّ، فإنّه إذا كان الحكم يعمّ النوعين كان قوله: (وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّداً) فزاد اللفظ، ونقص المعنى، وكان هذا ممّا يصان عنه كلام أدنى الناس حكمة فكيف كلام الله الذي هو خير الكلام وأفضله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، والجمهور القائلون: بوجوب الجزاء على المخطئ يثبتون ذلك بعموم السنّة والآثار، وبالقياس على قتل الخطأ في الآدمي، ويقولون: إنّما خصّ المتعمّد بالذكر لأنّه ذكر من الأحكام ما يخصّ به المتعمّد وهو الوعيد لقوله: (لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) فلمّا ذكر الجزاء والانتقام كان المجموع مختصاً بالمتعمّد ولم يلزم أن يثبت بعضه مع عدم العمد، ومثل هذا قوله: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خَفْتُمْ أن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ) فإنّه أراد بالقصر قصر العدد وقصر الأركان، وهذا القصر الجامع للنوعين متعلّق بالسفر والخوف، ولا يلزم من الاختصاص بمجموع الأمرين أن لا يثبت أحدهما مع أحد الأمرين، ولهذا نظائر، ولذلك كان ينبغي أن يسأله أقتله وهو ذاكر لإحرامه، أو ناس، فإنّ في الناسي نزاعاً أعظم ممّا في الجاهل، ويسأل هل قتله لكونه صال عليه، أو لكونه اضطر إلى مخمصة أو قتله عبثاً ظلماً بلا سبب، وأيضاً فإنّ في هذه التقاسيم ما يبيّن جهل السائل، وقد نزّه الله من يكون إماماً معصوماً عن هذا الجهل، وهو قوله: (أفي حلّ قتل أم في حرم) فإنّ المحرم إذا قتل الصيد وجب عليه الجزاء سواءً كان في الحلّ أم في الحرم فاتّفاق المسلمين، والصيد الحرمي يحرم قتله على المحلّ والمحرم، فإذا كان محرماً وقتل صيداً حرمياً توكّدت الحرمة ولكن الجزاء واحد.
وأمّا قوله: (مبتدئاً أو عائداً) فإنّ هذا فرق ضعيف لم يذهب إليه إنسان من أهل العلم، وأمّا الجماهير فعلى أنّ الجزاء يجب على المبتدئ وعلى العائد وقوله في القرآن: (وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) قيل: إنّ المراد من عاد إلى ذلك في الإسلام بعدما عفا الله عنه في الجاهلية، وقيل: نزول هذه الآية كما قال: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) وقوله: (وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ) وقوله: (قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ) يدلّ على ذلك، إنّه لو كان المراد غفر الله في أوّل مرّة لما أوجب عليه جزاءً، ولا انتقم منه وقد أوجب عليه الجزاء أوّل مرة.
وقال: (لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ) فمن أذاقه الله وبال أمره كيف يكون قد عفي عنه، وأيضاً قوله: (عمّا سلف) لفظ عامّ واللفظ العامّ المجرّد عن قرائن التخصيص لا يراد مرّة واحدة، فإنّ هذا ليس من لغة العرب، ولو قدر أنّ المراد بالآية عفا الله عن أوّل مرّة، وإنّ قوله: (ومن عاد) يراد به العود إلى القتل فإنّ انتقام الله منه إذا عاد لا يسقط الجزاء عنه فإنّ تغليظ الذنب لا يسقط الواجب كمن قتل نفساً بعد نفس لا يسقط عنه قود ولا ديّة ولا كفّارة..).
وحفل كلام ابن تيميّة بالمغالطات التي هي أبعد ما تكون عن الحقّ وألصق ما تكون بالباطل، والتي كان منها ما يلي:
أولاً: إنّه برّأ يحيى ونزّهه من الإقدام على امتحان الإمام (عليه السلام) فهو - على حد تعبيره - أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص، والذي نراه - حسب التحقيق العلمي - أنّه لا مانع من إقدام يحيى على ذلك بعد ما طلب منه العباسيون، ومنّوه بالأموال، وقد كان القضاء في العصر العباسي أداة بيد السلطة، فكانوا يسايرون رغبة الخلفاء ويقضون ويفتون على حسب ميولهم، وكان ممّا رواه المؤرّخون في ذلك، إنّ هارون الرشيد قد شغف بجارية لأبيه المهدي، كان قد دخل بها فامتنعت عليه، وقالت له: (لا أصلح لك إنّ أباك قد طاف بي..).
فلم يمتنع عنها وازداد شغفه وغرامه بها، فأرسل خلف القاضي أبي يوسف فقال له: (أعندك شيء في هذا..).
فأفتى أبو يوسف بما وافق هوى هارون وخالف كتاب الله وسنّة نبيّه قائلاً: (يا أمير المؤمنين أوَ كلمّا ادّعت أمَة شيئاً ينبغي أن تصدّق لا تصدّقها، فإنّها ليست بمأمونة..).
وقد خالف بفتواه ما حكم به الإسلام صراحة من أنّ النساء مصدقات على فروجهن، وعلّق ابن المبارك على هذه الفتوى بقوله:
(لم أدرِ ممّن أعجب من هذا الذي قد وضع يده في دماء المسلمين وأموالهم لا يتحرّج عن حرمة أبيه، أو من هذه الأمة التي رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين، أو من هذا فقيه الأرض وقاضيها!! قال: اهتك حرمة أبيك واقض شهوتك، وصيّره في رقبتي..).
وهناك فتاوى كثيرة لأبي يوسف شذّت عن القواعد الفقهيّة، واتّفقت مع رغبات السلطة الحاكمة.. إنّ القضاء لم يكن مستقلاً في العصر العباسي وإنما كان خاضعاً لرغبات الخليفة وميوله.
ثانياً: إن هذه المسألة التي سأل يحيى عنها الإمام (عليه السلام) ليست من المسائل البسيطة - كما يقول ابن تيميّة - وإنّما هي من دقائق علم الفقه باعتبار ما يتفرّع عليها من الفروع وما يتشعّب عليها من المسائل، وأكبر الظنّ أن يحيى إنّما سأل الإمام عنها باعتبار ذلك إذ ليس من السذاجة، وعدم الدراية بشؤون الفقه حتى يسأل الإمام عن مسألة بسيطة.
ثالثاً: إنّ ابن تيمية ذكر أن الإمام (عليه السلام) لم يعرض إلى بيان حكم هذه الأقسام التي فرّعها على المسألة، وهذا يدلّ على عدم تتبّعه، ونظرته للأمور بصورة سطحية فإنّ الإمام (عليه السلام) قد تعرض بالتفصيل لأحكام هذه الأقسام - كما سيأتي -.
رابعاً: أنكر ابن تيميّة أن يكون الإمام (عليه السلام) عالماً بأحكام هذه الأقسام فقد قال: (ومجرّد التقسيم لا يقتضي العلم بأحكام هذه الأقسام) إنّ الإمام الذي استمدّ علومه من آبائه العظام الذين هم ورثة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) قد عرض بصورة شاملة لبيان أحكام الأقسام، ولكن ابن تيميّة قد وضع حجاباً على عينيه فلم يبصر ما ذكره الإمام (عليه السلام).
خامساً: ذكر ابن تيمية أنّ ذكر الأقسام الممكنة إن كان واجباً فلم يستوفِ - أي الإمام - الأقسام، وإن لم يكن واجباً فلا حاجة إلى ذكر بعضها، إنّي لا أعرف كلاماً حافلاً بالمغالطات مثل هذا الكلام إذ أي علاقة أو ربط بين الحكم التكليفي الإلزامي وهو الوجوب وبين ذكر الأقسام التي أدلى بها الإمام، لقد فرّع الإمام على سؤال يحيى تلك الفروع ومن الطبيعي أنّ ذكرها غير مرتبط أصلاً بأي حكم من الأحكام.
سادساً: من مؤاخذات ابن تيمية على كلام الإمام أنّه لم يذكر المتعمّد والمخطئ، وهو أحقّ بالذكر من غيره، وهذا من الغرابة بمكان لقد أدلى الإمام (عليه السلام) بذلك، ولم يهمله، ولكن ابن تيمية قد أخفاه للتشهير بالإمام، والنيل منه.
سابعاً: من مؤاخذات ابن تيمية على الإمام (عليه السلام) إنّه لم يستوفِ ذكر الأقسام، وقد عدّ ابن تيميّة جملة منها، وهذا من المغالطات لأنّ الإمام (عليه السلام) ليس في مقام بيان استيعاب جميع صور المسألة حتى يشكل عليه بذلك، وإنّما ذكر بعض صورها لإفحام يحيى.
هذه بعض المؤاخذات التي تواجه كلام ابن تيمية الذي خلا من كلّ صيغة علمية..
ولنعد بعد هذا إلى ما جرى للإمام (عليه السلام) بعد فشل يحيى في مسألته.
خطبة العقد:
وبعد ما أفحم يحيى بن أكثم، وظهر عليه العجز، وبان لحضّار الحفل فضل الإمام أبي جعفر (عليه السلام) وتقدّمه في العلم على غيره - مع صغر سنّه - التفت إليه المأمون فقال له:
(أتخطب يا أبا جعفر؟..).
وأظهر الإمام (عليه السلام) الرضا بذلك، فأسرع المأمون قائلاً: (اخطب - جعلت فداك - لنفسك فقد رضيتك، وأنا مزوّجك أمّ الفضل ابنتي، وإن رغم قوم لذلك.).
وانبرى الإمام فأنشأ خطبة العقد قائلاً:
(الحمد لله إقراراً بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيته، وصلى الله على سيد بريته، والأصفياء من عترته، أما بعد: فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام، فقال سبحانه: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنم الله من فضله والله واسع عليم).
ثمّ إنّ محمد بن علي بن موسى يخطب أمّ الفضل بنت عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدّته فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) خمسمائة درهم جياداً فهل زوّجتني يا أمير المؤمنين على هذا الصداق؟..).
وانبرى المأمون بحسب وكالته عن ابنته أو ولايته عليها فيما إذا كانت صغيرة، فقال: (نعم قد زوجتك يا أبا جعفر على هذا الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح؟).
قال الإمام (عليه السلام): قد قبلت ذلك ورضيت به وأمر المأمون الناس على اختلاف مراتبهم بالجلوس وعدم التفرّق من المجلس، قال الريّان: ولم نلبث أن سمعنا أصوات الملاحين في محاوراتهم، فإذا الخدم يجرّون سفينة قد صنعت من الفضّة قد شدّت بحبال من الإبريسم، وهي مملوءة من الغالية، فأمر المأمون - أولاً - بأن تخضّب لحاء الخاصة، وبعدهم العامة وتطيّب الجميع، ثمّ وضعت الموائد فأكل الناس منها.
المأمون يطلب إيضاح المسألة:
وطلب المأمون من الإمام أبي جعفر (عليه السلام) إيضاح المسألة السابقة التي سأله عنها يحيى بن أكثم، فأجابه (عليه السلام) إلى ذلك، وقد روي جوابه بصورتين:
الأولى: ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلاً عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام)، وقد جاء في الجواب:
(إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ، وكان الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً، وإن قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم، وليس عليه القيمة لأنّه ليس في الحرم، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ لأنه من الحرم، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة، وكذلك في النعامة بدنة، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً فإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، وإن كان ظبياً فعليه شاة فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقّاً واجباً أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحره بمكّة في فناء الكعبة، ويتصدّق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفاً، وكذلك إذا أصاب أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة، ويتصدّق بمثل ثمن شاة، وإن قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم يتصدّق به، ودرهم يشتري به علفاً لحمام الحرم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم، وكلّما أتى به المحرم بجهالة وخطأ فلا شيء عليه إلاّ الصيد فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد، وكلّما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه، وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممّن ينتقم الله منه، وإن دلّ على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء والمصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الآخرة، وإن أصابه ليلاً أو نارهاً فلا شيء عليه، إلاّ أن يتصيّد، فإن تصيّد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء والمحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكّة.
وأمر المأمون أن يُكتب ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام) والتفت المأمون إلى أهل بيته الذين أنكروا تزويجه فقال لهم: هل فيكم من يجيب بهذا الجواب؟ قالوا: لا والله ولا القاضي.. يا أمير المؤمنين كنت أعلم به منّا فقال: ويحكم!! أما علمتم أنّ أهل هذا البيت ليسوا خَلقاً من هذا الخَلق، أما علمتم أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بايع الحسن والحسين (عليهما السلام) وهما صبيّان، ولم يبايع غيرهما طفلين، أو لم تعلموا أنّ أباهم علياً (عليه السلام) آمن برسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو ابن تسع سنين فقبل الله ورسوله إيمانه، ولم يقبل من طفل غيره ولا دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) طفلاً غيره، أولم تعلموا أنّها ذرّية بعضها من بعض يجري لآخرهم ما يجري لأوّلهم.
وألمّ جواب الإمام بأحكام جميع جوانب الصيد وفروعه، سواء في الحجّ أم في العمرة، في الحلّ كان الصيد أم في الحرام، فيما إذا كان الصائد محرماً.
الثانية: ما رواها الشيخ المفيد أنّ المأمون قال لأبي جعفر (عليه السلام): إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل الصيد لنعلمه ونستفيده؟
فقال أبو جعفر (عليه السلام): نعم إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ، وكان الصيد من ذوات الطير، وكان من كبارها فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً، فإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبياً فعليه شاة، فإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه، وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد له المأثم وهو موضوع عنه في الخطأ والكفّارة على الحرّ في نفسه وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة.
فقال له المأمون: أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك.
أما الرواية الأولى فهي أوسع وأكثر شمولاً لأحكام الصيد في الحجّ دون الرواية الثانية.
الإمام يسأل يحيى:
وطلب المأمون من الإمام الجواد (عليه السلام) أن يوجّه سؤالاً إلى يحيى بن أكثم فأجابه الإمام (عليه السلام) إلى ذلك والتفت إلى يحيى فقال له:
(أسألك؟..).
فأجابه يحيى بتأدّب:
(ذاك إليك، جعلت فداك، فإن عرفت جواب ما تسألني عنه، وإلاّ استفدت منك).
فقدّم له الإمام سؤالاً شبيهاً باللغز وذلك لمصلحة تقتضيها الظروف التي هو فيها، والتي كان منها إظهار فضله أمام العباسيّين الذين جحدوا فضله وفضل آبائه، قال (عليه السلام):
(أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل النهار فكان نظره إليها حراماً عليه، فلما ارتفع النهار حلّت له، فلمّا زالت الشمس حرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر حلّت له، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه، فلمّا دخل عليها وقت العشاء الآخرة حلّت له، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلمّا طلع الفجر حلّت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلّت له؟ وحرمت عليه؟.
وبهر يحيى، وحار في الجواب، والتفت إلى الإمام قائلاً:
(والله ما اهتدي إلى جواب هذا السؤال، ولا أعرف الوجه فيه، فإن رأيت أن تفيدنا فيه؟..).
وأخذ الإمام في تحليل المسألة قائلاً:
(هذه أمَة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار فكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له، فلمّا كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر تزوّجها فحلّت له، فلمّا كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظهار فحلّت له، فلمّا كان في نصف الليل طلقّها واحدة فحرمت عليه، فلمّا كان عند الفجر راجعها فحلّت له..).
وذهل الحاضرون من علم الإمام (عليه السلام) - وهو بهذا السنّ - وأقبل المأمون على أسرته قائلاً:
(هل فيكم أحد يجيب عن المسألة بمثل هذا الجواب، أو يطرق القول فيما تقدّم من السؤال؟..).
فانبروا جميعاً قائلين:
(لا والله إنّ أمير المؤمنين أعلم بما رأى..).
لقد آمنوا بفضل الإمام بعد ما رأوه قد خاض مع يحيى أعقد المسائل وأدقّها، ولم يهتِد المأمون ولا يحيى إلى الإجابة عنها.
هدايا بمناسبة عقد الزواج:
ولما كان اليوم الثاني من بعد إجراء عقد الزواج حضر الناس في البلاط العباسي وفي مقدمتهم قادة الجيش، وسائر الجهاز الرسمي، وغيرهم ومن عامة الناس، وهم يرفعون آيات التهاني إلى الإمام الجواد (عليه السلام) وإلى المأمون بهذه المناسبة السعيدة، وأمر المأمون بأن تقدّم لهم الهدايا والعطايا، فقدمت لهم ثلاثة أطباق من الفضة فيها بنادق مسك وزعفران معجون في أجواف تلك البنادق، وفيها رقاع مكتوبة بأموال جزيلة، وعطايا سنيّة، وإقطاعات فأمر المأمون بنثرها على القوم في خاصّته، فكان كلّ من وقع في يده بندقة أخرج الرقعة التي فيها، والتمسه، فأطلق له، ووضعت البدر فنثر ما فيها على القوّاد وغيرهم، وانصرف الناس وهم أغنياء بالجوائز والعطايا، وتقدّم المأمون بالصدقة على كافة المساكين.
احتفاف الجماهير بالإمام:
وأحيط الإمام الجواد أثناء إقامته في بغداد بهالة من التكريم والتعظيم والتفّت حوله الجماهير فقد رأت فيه امتداداً ذاتياً لآبائه الطاهرين الذين أضاءوا الحياة بجوهر الإسلام وواقع الإيمان، فكان الإمام إذا سار في الشارع اصطفّت له المارة وعلا منها التكبير والتهليل، وهي ترفع صوتها عالياً:
(هذا ابن الإمام الرضا).
وقد حدث عن مظاهر ذلك التكريم القاسم بن عبد الرحمن، وكان زيدياً، قال: خرجت إلى بغداد، فرأيت الناس يتشوفون ويقفون، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ابن الرضا، فقلت: والله لأنظر إليه، فطلع، وكان راكباً على بغل أو بغلة، فلعنت أصحاب الإمامة إذ يقولون: إنّ الله افترض طاعة هذا، وبصر بي الإمام فعدل إليَّ، وقال: يا قاسم بن عبد الرحمن (أبشراً واحداً نتّبعه إنّا إذاً لفي ضلال وسعر) وذهلت لمّا عرف نيّتي، وقلت بإمامته.
محاضراته في بغداد:
واستغل الإمام أبو جعفر (عليه السلام) مدّة بقائه في بغداد بالتدريس وبلورة الفكر العامّ بالعلوم والمعارف الإسلامية، وكان يلقي محاضراته القيّمة على العلماء والرواة في بهو بيته، وقد تناولت مختلف العلوم والفنون من علم الحديث، والتفسير، وعلم الفقه، وعلم الكلام، وعلم الأصول إلاّ أنّ علم الفقه قد حظي بالجانب الأكبر من اهتمامه.
سفره إلى يثرب:
وسافر الإمام أبو جعفر (عليه السلام) بعد أن عقد على أمّ الفضل إلى يثرب، وقد استقر بها حفنة من السنين، وقد قام بشؤون العلويّين، كما قام بإعاشة الفقراء والمحرومين، فكان موئلهم، أمّا هو فقد عاش عيشة بسيطة كعيشة آبائه، فلم يرفّه على نفسه، وإنّما حمّلها من أمره رهقاً.
وقد احتفّ به الفقهاء والعلماء ورواة الحديث، وهو يفيض عليهم من نمير علومه ومعارفه، وقد روى عنه العلماء جوانب كثيرة من الفقه وغيره وقد ألمحنا إليها في البحوث السابقة.
بناؤه بأمّ الفضل:
وبعدما بلغ الإمام الجواد (عليه السلام) سنّ الخامسة عشر سافر إلى بغداد للزواج بأمّ الفضل التي عقد عليها، وقدم إلى بغداد في شهر صفر ليلة الجمعة، وأقام فيها.
وكان المأمون بتكريت، فقصده، وقابله المأمون بمزيد من الحفاوة والتكريم، وأمر أن تدخل عليه زوجته أمّ الفضل فأدخلت عليه في دار أحمد بن يوسف، وكانت داره على شاطئ دجلة، فأقام بها حتى موسم الحجّ ثمّ خرج منها.
المهنّئون بزواجه:
ووفد جماعة من أعيان بغداد وغيره على الإمام وهم يهنّئونه بزواجه، ويبدون أفراحهم بهذه المناسبة، وكان ممّن وفد عليه محمد بن علي الهاشمي ولنستمع إلى حديثه، قال: دخلت على أبي جعفر صبيحة عرسه بابنة المأمون، وكنت تناولت من أوّل الليل دواءً فأصابني العطش، وكرهت أن أدعو بالماء، فنظر أبو جعفر في وجهي، وقال: أراك عطشاناً؟ قلت: أجل، قال: يا غلام اسقنا ماءً فقلت في نفسي: الساعة يأتون بماء مسموم، واغتممت لذلك، فأقبل الغلام ومعه الماء، فتبسّم في وجهي، ثمّ قال: يا غلام ناولني الماء فتناوله وشرب، ثمّ ناولني فشربت وأطلت عنده، وعطشت فدعا بالماء، وفعل كما فعل بالمرة الأولى، وخرجت من عنده وأنا أقول: أظنّ أنّ أبا جعفر يعلم ما في النفوس كما تقول الرافضة.
لقد خاف محمد على الإمام أبي جعفر (عليه السلام) من العباسيين أن يغتالوه بالسمّ ولا تمنعهم مصاهرتهم له لأنّها لم تكن عن حسن نيّة.
وممن وفد على الإمام (عليه السلام) مهنّئاً أبو هاشم الجعفري، فقد قال له: (لقد عظمت علينا بركة هذا اليوم - أي يوم زواج الإمام -).
وردّ عليه الإمام قائلاً: (يا أبا هاشم عظمت بركات الله علينا فيه..).
لقد أسند أبو هاشم عظمة البركة إلى اليوم الذي تزوّج فيه الإمام والحال ليس كذلك فإنّ الأيام لا تُوجد البركة وإنما يوجدها الله خالق الكون وواهب الحياة.. وشعر أبو هاشم انّ كلامه لا يخلو من زحاف فقال للإمام:
(يا مولاي فما أقول في اليوم؟).
(تقول: فيه خيراً فإنّه يصيبك).
(يا مولاي افعل هذا ولا أخالفه).
إنّ الأيام ليس فيها بركة أو خير على الإنسان، وإنّما ذلك بيد الله تعالى فهو الذي يفيضه على من يشاء من عباده، وقد قال له الإمام: (إذاً ترشد ولا ترى إلاّ خيراً).
مغادرته بغداد:
وغادر الإمام محمد الجواد (عليه السلام) بغداد بعد زواجه بأمّ الفضل، وقد خرج معه أهله وعياله فتوجّه بهم إلى بيت الله الحرام لأداء الحجّ وقد سرّ العباسيون بمغادرته بغداد، وذلك لحقدهم البالغ عليه، لما ظهر من عظيم فضله، وانتشار علمه على صغر سنّه، الأمر الذي صار حديث الأندية والمجالس في بغداد وغيرها فخافوا أن يعهد له المأمون بالخلافة كما عهد لأبيه الإمام الرضا (عليه السلام) من قبل.. لقد غادر الإمام بغداد ليقيم في يثرب ويكون بمنأى عن مؤامرات العباسيين وأحقادهم.
كرامة للإمام:
وأجمع المؤرّخون والرواة على أنّ الإمام لمّا خرج من بغداد متوجّهاً إلى يثرب جرت له في أثناء الطريق كرامة، ولنترك الشيخ المفيد يحدّثنا عنها قال: لمّا توجّه أبو جعفر (عليه السلام) من بغداد إلى المدينة ومعه أمّ الفضل خرج الناس يشيّعونه، ولمّا صار إلى شارع باب الكوفة انتهى إلى دار المسيّب عند مغيب الشمس، فنزل ودخل المسجد، وكان في صحنه نبقة لم تحمل بعد فدعا بكوز فيه ماء فتوضّأ في أصل النبقة، وقام (عليه السلام) فصلى بالناس صلاة المغرب، فقرأ في الأولى منها الحمد وإذا جاء نصر الله وقرأ في الثانية الحمد، وقل هو الله، وقنت قبل ركوعه فيها، وصلى الثالثة وتشهّد وسلم، ثمّ جلس هنيئة يذكر الله جلّ اسمه، وقام من غير أن يعقب فصلى النوافل أربع ركعات، وعقب تعقيبها، وسجد سجدتي الشكر ثمّ خرج فلمّا انتهى إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حملاً حسناً، فتعجّبوا من ذلك، وأكلوا منه فوجدوا نبقاً حلواً لا عجم له، وودّعوه ومضى من وقته.
إنّ الله تعالى قد منح أئمة أهل البيت من الكرامات والمعاجز ما لا يحصى كما منح جدّهم الرسول (صلى الله عليه وآله) ليؤمن بهم الناس، ويلتجأوا إليهم في السرّاء والضرّاء، فيجعلوا منهم وسائط إلى الله تعالى.
أمّ الفضل تشكو الإمام إلى أبيها:
وشاء الله تعالى أن تحرم أمّ الفضل الذرية من الإمام الجواد (عليه السلام) فاضطرّ الإمام (عليه السلام) إلى أن يتسرّى ببعض الإماء ممّن لها دين، فرزقه الله منها الذرية الصالحة، فتميّزت أمّ الفضل غيظاً، ورفعت رسالة إلى أبيها تشكو فيها صنع الإمام معها، فأجابها المأمون: (يا بنيّة إنا لم نزوجك أبا جعفر لنحرّم عليه حلالاً فلا تعاودي لذكر ما ذكرت بعدها) وظلّت أمّ الفضل حاقدة على الإمام، حتى اغتالته بالسمّ كما يقول بعض المؤرخين.
المرتّب السنوي للإمام:
وأجرى المأمون مرتّباً سنوياً للإمام أبي جعفر (عليه السلام) يبلغ مليون درهم ولم ينفق الإمام هذه الأموال مع ما يرد إليه من الحقوق الشرعية على شؤونه الخاصّة، وإنّما كان ينفقها - بسخاء - على الفقراء والمحرومين من العلويّين وغيرهم.
وفاة المأمون:
وخرج المأمون من عاصمته بغداد إلى طرطوس للتنزّه والراحة، وقد أعجبته كثيراً، وذلك لما تتمتّع به من المناظر الطبيعية، وأخذ يتجوّل في بعض متنزّهاتها فراقه مكان فيها كان حافلاً بالأشجار والمياه الجارية وعذوبة الهواء، فأمر أصحابه أن ينزلوا فيها، فنزلوا فيها، ونصبت لهم المائدة فجلسوا للأكل، والتفت المأمون إلى أصحابه فقال لهم: إنّ نفسي تطالبني الآن برطب جني ويكون ازاذ وبينما هم في الحديث إذ سمعوا قعقعة ركب البريد الواصل من بغداد، وفيه أربع كثات من الخوص ملؤها رطب زاذ لم يتغيّر كأنّه جُنِي في تلك الساعة فقدّمت بين يديه، وشعر من ذلك بقرب أجله المحتوم فكان يقول:
(ملكت الدنيا، وذلّت لي صعابها، وبلغت آرابي).
وكان يذكر وصول الرطب في أكثر أوقاته، وهو يقول: آخر عهدي بأكل الرطب، فكان كما قال: فقد ألمّت به الأمراض واشتدّت به العلّة، وكان نازلاً في دار خاقان المفلحي، خادم الرشيد، ولمّا دنا منه الموت أمر أن يفرش له الرماد، ويوضع عليه، ففعل له ذلك،وكان يتقلّب على الرماد، وهو يقول: (يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه).
واشتدّ به النزع، وكان عنده من يلقّنه فعرض عليه الشهادة، وكان ابن ماسويه الطبيب حاضراً، فالتفت إلى من يلقّنه قائلاً:
(دعه فإنّه لا يفرّق في هذه الحال بين ربّه وماني..).
وفتح المأمون عينيه، فقد لذعته هذه الكلمات، وقد أراد أن يبطش به إلاّ أنّه لم يستطع فقد عجز عن الكلام، ولم يلبث قليلاً حتى وافاه الأجل المحتوم، وكان عمره (49 سنة) أمّا مدّة خلافته فعشرون سنة، وخمسة أشهر وثمانية عشر يوماً، ويقول فيه أبو سعيد المخزومي:
هل رأيت النجوم أغنت عن المأ مون فـــي ثبت ملكه المأسوس
خلفوه بعرصــــــــتي طرطوس مثل ما خلّفوه أباه بطوس
وكان عمر الإمام أبي جعفر (عليه السلام) في ذلك الوقت يربو على اثنين وعشرين عاماً، وكان - فيما يقول المؤرّخون - ينتظر موت المأمون بفارغ الصبر لعلمه أنّه لا يبقى بعده إلاّ قليلاً ثمّ يرحل إلى جوار الله، ويفارق هذا العالم المليء بالفتن والأباطيل، وقد قال:
(الفرج بعد وفاة المأمون بثلاثين شهراً..).
ولم يلبث بعد وفاة المأمون إلاّ ثلاثين شهراً حتى توفّي.
وفي نهاية هذا الحديث نودّ أن نبيّن أن المأمون أسمى شخصيّة سياسية وعلمية من ملوك بني العباس فقد استطاع أن يتخلّص من أشدّ الأزمات السياسية التي أحاطت به، وكادت تقضي على ملكه وسلطانه وكان من ذكائه الخارق أنّه تقرّب إلى العلويين وأتباعهم فأوعز إلى أجهزة الأعلام بنشر فضل الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) على جميع الصحابة كما ردّ فدكاً إلى العلويّين، وعهد إلى الإمام الرضا (عليه السلام) بولاية العهد، وزوّج الإمام الجواد (عليه السلام) من ابنته أمّ الفضل، ولم يصنع ذلك عن إيمان أو إخلاص لأهل البيت (عليهم السلام) وإنّما صنع ذلك ليتعرّف على الحركات السرية والأجهزة السياسية التي كانت تعمل تحت الخفاء للإطاحة بالحكم العباسي وإرجاع الخلافة إلى العلويّين.
لقد استطاع المأمون بعد هذه العمليات التي قام بها أن يتعرّف على الخلايا وما تقوم به من النشاطات السياسية ضدّ الحكم العباسي وقد جهد قبله ملوك بني العباس أن يتعرّفوا على ذلك فلم يستطيعوا ولم يهتدوا إلى ذلك بالرغم ممّا بذلوه من مختلف المحاولات التي كان منها التنكيل الشديد بأنصار العلويّين وشيعتهم، وإنزال أقصى العقوبات بهم، فإنّهم لم يصلوا إلى أيّة معلومات عنهم، ولم يكشفوا أي جانب من جوانبهم السياسية.



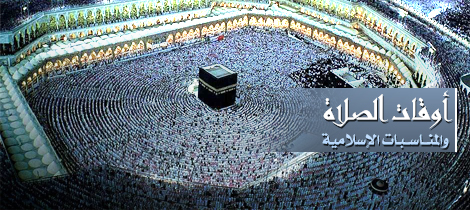
التعليقات (0)