واصلت حسينية الحاج أحمد بن خميس سلسلة المجالس الحسينية و ذلك في ليلة الرابع من موسم محرمّ لعام 1447 هـ ، وقد سبق البرنامج تلاوة للقرآن الكريم بصوت القارئ قاسم فيصل ، وبعدها زيارة الإمام الحسين بصوت الرادود علي سلمان طريف ، و تحت عنوان " سُنّة التغيير " ، ابتدأ سماحته بالآية الكريمة : "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". لقد أكدت العديد من الآيات القرآنية على ضرورة التدبر في الحوادث التاريخية، وهذا ما يتجلى في قوله تعالى : "أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا" . ومثل هذا المقطع ورد في سورة يوسف (الآية 109) حيث يقول تعالى: "أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ". من مجموع هذه الآيات وغيرها، يتبلور لدينا المفهوم القرآني القائل بأن الساحة التاريخية مليئة بالعظات و العبر والسنن والضوابط. لذا، من الواجب على الإنسان أن يقف ويتعظ مما مضى ليُصَحّح مساره في المستقبل. وهذا ما سنحاول استقراءه من خلال عدة نقاط.
النقطة الأولى : سنة النصر حق طبيعي لا إلهي محض ، قد يستعجب البعض من هذه المقولة ولكن القرآن الكريم، عندما تحدث عن الانكسار الجزئي للمسلمين في معركة أحد، لم يقل إن رسالة الإسلام قد هُزمت أو تهاوت. فالجواب قاطع بالنفي؛ لأن رسالة السماء لا تهزم ولن تهزم أبدًا. بل إن رسالة السماء لا تخضع لمقاييس النصر والهزيمة بالمعنى المادي، فقد تعهد الله عز وجل بحفظها، إذاً، من الذي يُهزم؟ الذي يتعرض للهزيمة هو الإنسان، حتى وإن كان ذلك الإنسان مجسدًا لرسالة السماء. وذلك لأن الإنسان تتحكم فيه سنن التاريخ وضوابطه. فالقرآن الكريم يصف المسلمين بأنهم أناس حالهم كحال غيرهم، وأن هذه القضية قضية حقيقية خاضعة لسنن التاريخ وضوابطه. يقول تعالى: "وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ" . لقد انتصر المسلمون في معركة بدر لتوافر الشروط الموضوعية التي تفرضها سنن التاريخ، بينما انكسروا جزئيًا في معركة أحد لفقدان هذه الشروط. لذا عبر القرآن الكريم: "إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ". فالدنيا دوّارة، واليوم لك وغدًا عليك. إذا كان اليوم لك، فلا تبطش وتستهلك كل قوتك، لأن الدنيا تدور دورات كبيرة وعظيمة. إن النصر ليس سنة إلهية مطلقة، بل هو سنة طبيعية بقدر توفر الشروط الموضوعية للنصر، وكل هذه الشروط تكون وفق منطق سنن التاريخ التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونيًا لا تشريعيًا. لذا انتصر المسلمون في بدر لتوافر الشروط وهُزموا جزئيًا في أحد لفقدان نفس الشروط. هذا يجب أن يترسخ في عقيدة الإنسان المؤمن، وأن مسألة الانتصار تتطلب جهدًا وعملاً حثيثًا لتوفير شروطه، لا أن يجلس المرء في بيته ويقول: "سينصرني الله"، بل يجب أن ينهض ويتعاطى مع هذه الشروط.
النقطة الثانية: سنة الامتحان الإلهي ، عند مطالعة القرآن الكريم، نجد هذه الآية العظيمة: "أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ" (سورة البقرة، الآية 214). يقول صاحب تفسير الأمثل ، إن هذه الآية تبين أن بعض المسلمين لديهم عقيدة خاطئة وهي أن إظهار الإيمان بالله وحده يكفي لدخول الجنة. لذا، لم يوطنوا أنفسهم على الصبر على البلاء، ولا على مواجهة البأساء والضراء والمشاق، بل قالوا: ما دمنا نؤمن بالله، فالله سيتكفل بإصلاح أمورنا ودفع كيد الأعداء عنا. هذه النظرة خاطئة قطعًا. يقول القرآن الكريم: "أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ" (سورة العنكبوت، الآية 2). جاءت الآية لتصحح هذه العقيدة الخاطئة والفهم المغلوط، عبر إبراز سنة إلهية دائمة في هذه الحياة، وهي أن المؤمنين يجب أن يستعدوا لمواجهة البلاء، البأساء والضراء. وقد تصل هذه البلايا إلى مستوى عظيم في قوته، كالزلزال الذي يهز المجتمع، أو منعطف خطير قد يؤثر على توجه الأمة، إما بالنجاة أو بالتسافل. يجب على الإنسان أن يقف عند هذا الأمر ويدقق في قول الحسين (ع) عندما قال: "وإذا مُحّصوا بالبلاء، قلّ الديانون". فكما تُعرف جودة الذهب بالطرق عليه، كذلك تعرف قوة الإيمان بالبلاء.
النقطة الثالثة : الشروط الموضوعية للنصر، عندما نأتي إلى القرآن الكريم، نقرأ هذه الآية الكريمة: "وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ" (سورة الأنعام، الآية 34). يقول بعض المفسرين في مصادرهم أن هذه الآية جاءت لتثبت قلب النبي الأكرم (ص)، وذلك عبر ذكر بعض الأمور التاريخية والحوادث التي جرت، وتقول له: هذه سنة طبيعية في الحياة. كما أن الرسل الذين مضوا تعرضوا لمثل هذه الأمور، سوف تتعرض إليها، ولكن في خاتمة الأمر سيكون النصر والفتح بين يديك ، لكن هذا النصر وهذا الفتح ليس هكذا، وإنما له شروط لا بد من توافرها. من ضمن هذه الشروط: الثبات والصبر. فالإنسان لابد أن يثبت ويصبر. لذا، قالت الآية الكريمة وهي توجه الخطاب لرسول الله (ص): "فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا" والنتيجة "حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۗ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ". تشير الآية إلى أن كلمات الله عز وجل لا يمكن أن تتبدل أو تتغير مهما تبدلت الدنيا وتغيرت. والسبب في ذلك هو العلاقة الوثيقة والرابطة بين مجموعة من القضايا والمواصفات والشروط، والتي ذكرها القرآن في أكثر من آية ومورد.
النقطة الرابعة : سنة تغيير البناء العلوي الاجتماعي ، ننطلق من هذه الآية الكريمة التي بدأنا بها الكلام ، يقول العلماء إن المكون الإنساني ينقسم إلى عنصرين أساسيين: البناء الداخلي أو المحتوى الداخلي للإنسان وهو الذي يشكل القاعدة، والوضع الاجتماعي وهو البناء العلوي. فلا يمكن أن يكون هناك تغيير في البناء العلوي إلا أن يكون هناك تغيير في المحتوى الداخلي للإنسان. وهكذا عندما ندقق في الآية الكريمة، نجد أن تغيير الأمم والمجتمعات يكون نتيجة لما يقوم به أفراد ذلك المجتمع من تغيير، سواء في نفوسهم أو في مواقفهم. هذا التغيير تارة يكون إيجابيًا، وتارة يكون سلبيًا. بمعنى أنه قد يغير الإنسان من السيء إلى الحسن، وهذا تغيير إيجابي. وتارة ينحدر ويتسافل، فيغير من الحسن إلى السيء. والإنسان باختياره وبملء إرادته يمضي في أي طريق ويتحمل كامل النتيجة والتبعات. هذا التغيير - كما يقولون - يجري في الأفراد وفي المجتمعات، لكن الابتداء يكون من الفرد ثم ينتقل إلى المجتمع. هذا المفهوم لا يكون إلا عبر خطوتين ضروريتين: الخطوة الأولى بيد الإنسان: "يغيروا ما بأنفسهم". الخطوة الثانية تكون بيد الله عز وجل: "يغير ما بقوم". فالإنسان مختار إما أن يغير للأحسن أو للأسوأ، أما الخطوة الثانية، فهي ليست باختيار الإنسان، لأن نتيجتها متعلقة بالخطوة الأولى. هذا المفهوم الذي ذكرته الآية الكريمة نجد مصداقه عندما نتابع شؤون الأمم السابقة في القرآن الكريم، حيث يشير إلى أن التغيير يبدأ من حيث ينتهي موقف تلك الأمم، ثم بعد ذلك يأتي موقف الله عز وجل بناءً على ما غيروا من مواقف وآراء في تلك المواقف السابقة. هذه المسألة، إذا طالعنا فيها الأمم التي مضت، نجد فيها شيئًا من القساوة والشدة، حتى أن بعض الأمم نزل عليها العذاب بسبب دعاء ذلك النبي. أما عندما نطالع حركة رسول الله (ص).
الكراني ليلة الرابع من شهر محرّم الحرام لعام 1447هـ/2025م




































































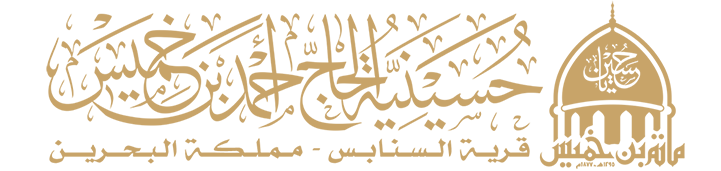


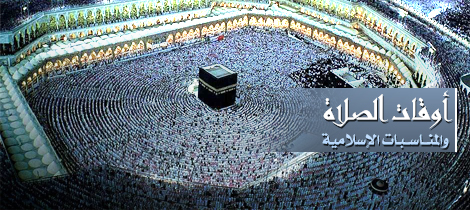
التعليقات (0)